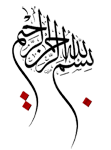بحث تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من صحيح البخاري
بحث تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من صحيح البخاري
المبحث الثاني: مصادره في تفسير الفاتحة
المفسر يرجع إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول اللهصلى الله عليه وسلم، وإلى كلام العرب، وإلى الأحوال المتعلقة بالنزول.
وهذه المراجع هي التي رجع إليها الصحابة والتابعون وأتباعهم، ثم صارت في تفاسيرهم فانتظم تفسيرهم، مرجعًا لمن جاء بعدهم، أيضًا.
ولو رجعت إلى التفاسير التي جاءت بعد الصحابة، فإنك لا تجد غير هذه المعلومات في تفسيرهم، وما زادوه من نحو وبلاغة وغيرها، فإنه يعود إلى أحد هذه المصادر في نهاية الأمر، وإنما استقلَّت وصارت علومًا بعد عصرهم.
ومما تجدرُ الإشارة إليه – وهو من الأهمية بمكان – أن مصادر السلف واحدة، ومنهجهم واحد، وليسوا كما يصوِّره بعضهم أنهم مدارس متباينة، لا، بل هم مدرسة واحدة متفقة في المنهج والمصدر، واختلاف الواحد منهم عن الآخر في الاستزادة من مصدر دون غيره لا يمثِّل اختلافًا منهجيًا حتى نجعلهم في مدارس متباينة.
ومهما اختلفت عباراتهم في التعبير عن تفسير لفظة أو جملة، فإن كثيرًا منها يأتلف في نهاية الأمر على معنى كليِّ واحد يدركه من كان له دِربة في التعامل مع أقوالهم، وكان ضابطًا لمعاني الكلام العربي.
والذي نحن بحاجة إليه في مقام هذا الإمام العظيم أن نعتني بمصادره، ونستجلي طريقته في استفادته منها، وطريقته في الانتقاء من هذه المصادر، فإنه إما أن يختار من متعدد في الأقوالِ، وإما أن يترك بعض المفردات لا يعرج عليها، ويختار غيرها فيذكرها.
المطلب الأول: النظائر القرآنية:
أ) المراد بالنظائر:
هي الألفاظ القرآنية التي لها معنى واحد في أكثر من آية (1).
ب) مثالها في حديث الباب:
قال البخاري: « وَالدِّينُ: الجَزَاءُ فِي الخَيْرِوَالشَّرِّ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {بِالدّيِنِ} (الإنفطار:9): بالحساب، {مَدِينِينَ}(الواقعة:86):مُحَاسَبِينَ».
ج) وجه استفادته من هذا المصدر في الباب:
أن الإمام البخاري جعل لفظة {الدّيِنِ}في الفاتحة، وفي التين والانفطار بمعنى واحد، وأضاف ما يدخل معها في الاشتقاق، وهو لفظ
(مَدِينِينَ)، وعلى هذا جرى عمل مؤلفي (الوجوه والنظائر) حيث لا يراعون مطابقة الكلمة للكلمة (4)، وإنما قد يدخلون فيها ما يقع من الاشتقاق الأصغر.
وهذا النوع من العلم قد عُني به البخاري في غير ما موطن، كما أشار إلى ذلك الباحث في منهجه في التفسير (2).
فائدة وتتميم:
هناك نوع من العلم قلَّما وقعت العناية به، وهو: النظائر بين الكتاب والسنة، والبخاري أورد جملة من الأحاديث في كتاب التفسير، وهي من هذا الباب.
ويمكن أن يدخل في ذلك ما ذكره في حديث الباب من قولهصلى الله عليه وسلم: «لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي القُرْآنِ»، مع قوله تعالى: {وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّن الْمَثَانِى وَالْقرْآنَ الْعَظَيمَ} (الحجر:87)؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم جعلها (أعظم سورة)، والقرآن جعلها (القرآن العظيم)، فبينهما مناسبة لفظية، والله الموفق.
المطلب الثاني: التفسير النبوي.
أ) المراد بالتفسير النبوي:
هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية مباشرة، بخلاف ما لو قال كلامًا لم يربطه بالآية، ثم قام المفسر بربط الحديث بالآية، فذاك نوع من استفادة المفسر من مصدر من أهم المصادر، وهو السنة النبوية.
ب) مثالها في حديث الباب:
ورد حديث أبي سعيد بن المعلى في الباب تفسيرين نبويين:
التفسير الأول: تفسيره لمعنى الاستجابة في قوله –تعالى–:{اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} (الأنفال:24).
فعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي المَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} (الأنفال:24).
التفسير الثاني: تفسيره لآية سورة الحجر: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}(الحجر:87) بأنها من أسماء الفاتحة أو أوصافها.
ففي الحديث السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن المعلى رضي الله عنه: (لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ). ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، قُلْتُ لَهُ: «أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ»، قَالَ:({الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}(الفاتحة:2)، هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ).
ج) وجه استفادته من هذا المصدر في الباب:
ووجه استفادته في
المثال الأول: أنه جعل مطلق ندائه يدخل في مراد الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم نبَّه على دخول ندائه الخاص في المراد من الآية.
ويظهر من الحديث أن أبا سعيد يعرف الآية، وتأخره عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيه احتمالان:
الأول: أنه لم يفهم أن في هذه الآية وجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في ندائه الخاصِّ.
الثاني: أن يكون هذا المعنى معروفًا عنده من الآية، لكنه غفل عنه، إذ إنه أكمل صلاته، وهي تطوع، وترك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجبة.
وأما وجه استفادته في
المثال الثاني: فهو تفسير نبوي صريح، وهو يدلُّ على أن العطف عطف صفات، وليس عطف تغاير.
المطلب الثالث: تفسير التابعين.
أ) المراد بتفسير التابعين:
بيان معاني القرآن الكريم بأقوال التابعين.
والتابعي: من لقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)، ويضاف في مفسريهم: وأخذ عنهم العلم.
ب) مثاله في حديث الباب:
قال البخاري: «قالَ مُجَاهِدٌ: {بِالدّيِنِ}(الإنفطار:9): بِالحِسَابِ، {مَدِينِينَ}(الواقعة:86): مُحَاسَبِينَ».
ج) وجه استفادته من هذا المصدر في الباب:
يظهر جليًا من تصريح البخاري استفادته تفسير {الدّيِنِ} من مجاهد رحمه الله، والبخاري كثيرا ما ينقل في كتاب التفسير عن مجاهد وغيره، مصرحًا باسمهم، وقد ينقل عن التابعين تفسير لفظة من القرآن دون التصريح باسمهم (4).
المطلب الرابع: التفسير اللغوي.
أ) المراد بتفسير اللغوي:
بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفرداته وتراكيبه في لغة العرب.
ب) مثاله في حديث الباب:
قال البخاري: «الدِّينُ: الجَزَاءُ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ».
ج) وجه استفادته من هذا المصدر في الباب:
والبخاري نقل هذا التفسير من أبي عبيد معمر بن المثنى (ت: 210) في كتابه (مجاز القرآن).
ولم يكن البخاري رحمه الله بِدعًا في هذا الأمر، بل كان بعض المحدثين يستفيدون مما دوَّنه اللغويون، وينقلون عنهم بيان مفردات ألفاظ العرب ثقة منهم بنقلهم وفهمه، واعتمادًا منهم على تخصُّصهم في نقل اللغة، ولذا تجد أنَّ اسمين من أسماء اللغويين تكثر في كتب التفسير وكتب (غريب الحديث)(5)، وهما الفراء (ت: 207)، وأبو عبيدة (ت: 210).
وهذا المنهج سلكه البخاري، فاستفاد منهما في مواطن من كتابه الصحيح، خصوصًا كتاب (التفسير).
والملاحظ أنه لم يكن يحرص على التصريح بأسمائهم، إلا فيما ندر (6)، مما يدعو إلى التساؤل عن سبب ذلك؟
وهذا النقل لا يُعدُّ كثيرًا بجانب الأصل العام للبخاري، وهو نقل الثابت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذه تُعدُّ من مزايا البخاري في صحيحه، إذ أضاف هذه الفوائد التي لها علاقة بالموضوع الذي يذكره، وإن كان ينتقي، ولا يذكر ذلك في كل باب أو تحت كل حديث.
* * *
المبحث الثالث
أنواع علوم القرآن التي أوردها في سورة الفاتحة
إن ستنطاق الأحاديث النبوية في مسائل العلم، واستنباطها منه مجال رحبٌ، وقد يغفل عنه طالب العلم وهو يقرر بعض المسائل العلمية.
وسأذكر ههنا بعض أنواع علوم القرآن التي دلَّ عليها حديث أبي سعيد بن المعلى الذي ذكره البخاري في المباحث الآتية.
المطلب الأول: علم غريب القرآن.
يُقصدُ بغريب القرآن: تفسير ألفاظ القرآن من جهة لغة العرب.
وقد شاع هذا الاستعمال، واستخدمه العلماء في كتبهم التي ألفوها في هذا الشأن.
1 – أورد البخاري في تفسيره لسورة الفاتحة معاني بعض الكلمات الغريبة مثل قوله: «وَالدِّينُ: الجَزَاءُ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ» .
2 – تفسير الدين بالجزاء أصله عند أبي عبيدة (ت: 210) في مجاز القرآن، قال: {الدّيِنِ}:
الحساب والجزاء، يقال في المثل: كما تدين تدان».
وجلُّ مادة تفسير المفردات القرآنية من جهة اللغة أخذه عن يحيى بن زياد الفراء (ت: 207)، وعن معمر بن المثنى (ت: 210). وهو ناقل منهما، ومفيد مما كتبوه، وليس له فيها تحرير مستقلٌ.
3 – البخاري لم يكن له رأي خاص في اللغة، خلافاً لمن ادعى ذلك(7)، فهو ناقلٌ في أغلب أحواله، ثقة منه بالمنقول عنهم من جهة اللغة.
تتميم:
لهذين الكتابين منزلة كبيرة عند العلماء، وقد نقلوا منهما كثيرًا، ونجد ذكرهما والنقل عنهما يتردد في بعض كتب التفسير التي اعتنت بآثار السلف؛ كتفسير الطبري (ت: 310)(8)، وتفسير ابن المنذر (ت:318)(9)، وتفسير الثعلبي (ت: 427)(10).
المطلب الثاني: علم أسماء السور.
1 – أشار الإمام البخاري إلى اسمين لها، فقال: «بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُمِّيَتْ أُمَّ الكِتَابِ...».
2 – من طريقة البخاري في العناوين التي يصدر بها أحاديث السورة ما يأتي:
الأول: أن يصدرها تحت عنوان «باب»، كما ههنا، قال: «بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ»، «باب سورة المائدة»، «باب سورة الروم»(11).
الثاني: أن يصدر تفسير السورة بلقبها دون ذكر لفظة «باب»، كقوله: (سورة البقرة، سورةآل عمران...) إلخ، أو بحكاية أول السورة؛ كقوله: (سورة إنا أعطيناك الكوثر).
3 – لم يُعن البخاري بتعديد أسماء السور، وإنما جاء ذلك في سورة الفاتحة فذكر اسمها، وزاد عليه اسمًا آخر، وهذا تصريح منه باسمين من أسماء الفاتحة التي تحظى بعدد كثير من الأسماء التي بلغت أكثر من عشرين اسم عند بعض العلماء.
ولكننا لا نجد هذا في غير هذا الموضع.
4 – قلَّما يورد خبرًا يتضمن اسم السورةٍ (12)، فمع أنه روى هذا الاسم الذي صدَّر به عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يورده هنا، فقد روى عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وهذا الاسم الوارد في هذا الحديث هو الذي صدَّر به تفسير سورة الفاتحة.
5 – وفي تفسير سورة الفاتحة علَّل البخاري لهذه التسمية (13)، فقال: « أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي المَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلاَةِ»، لكن هذا لا يكاد يوجد في غيرها، والله أعلم.
المطلب الثالث: علم فضائل السور.
1 – فضل القرآن، أو فضائل القرآن نوع من أنواع علوم القرآن التي كتب العلماء فيها كتبًا مستقلة، كما ضمَّنوه بعض كُتبهم، ومنهم البخاري الذي خصَّ «فضائل القرآن» بكتاب من صحيحه جعله بعد «كتاب التفسير».
2– قد أورد البخاري هذا الحديث «حديث أبي سعيد بن المعلى» في فضل سورة الفاتحة من كتاب «فضائل القرآن»، وهو ألصق به من كتاب التفسير.
3– المستقرئ لما كتبه العلماء من أحاديث فضائل القرآن أو سوره وآيه يمكن أن يقسم أنواع الفضائل التي أدخلوها إلى ما يأتي:
الأول: ما يخص قراءته صلى الله عليه وسلم بزمن معين، كقراءة سورة الإخلاص في الوتر.
الثاني: ما يرتبُّ عليه من الأجر، كذكره لسورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن.
الثالث: ما يرتب عليه من التأثير المحسوس، كالفاتحة التي قرأها الصحابي على اللديغ، فبرئ بإذن الله.
الرابع: ما يبين فضيلته العامة، كذكره صيغة «أفعل»، ومنه قوله هنا: (أعظم سورة).
وفضائل السور والآي منها ما هو صحيح؛ كهذا الحديث، ومنها ما هو ضعيف.
4– في الحديث إشارة لمسألة تفاضل سور القرآن وآياته. قال العلامة ابن الملقن: «فيه دلالة على فضيلة كلام الله بعضه على بعض، وهو الصواب».وقال الحافظ ابن حجر: «واستدل به على تفضيل بعض القرآن على بعض».
المطلب الرابع: علم المكي والمدني.
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن سورة الفاتحة مكية، وذهب بعضهم إلى أنها مدنيَّة، وقد دلَّ حديث أبي سعيد بن المعلى على أن سورة الفاتحة مكية؛ لأن الله امتنَّ على نبيه صلى الله عليه وسلم بها فيما مضى من زمنٍ قبل نزول قوله – تعالى –: (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ)(الحجر:87)، وسورة الحجر مكية، ومن ثمَّ فإن نزول السورة التي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم تكون قبل نزول هذه الآية؛ لذا لا يمكن أن تكون مدنية، والله أعلم (14).
وهذه الآية أحد حجج من أثبت مكيتها.
وبهذا يكون حديث أبي سعيد بن المعلى قد أشار إلى علم المكي والمدني، والله أعلم.
المطلب الخامس: علم عد الآي.
1 – علم عدِّ الآي من أنواع علوم القرآن التي اعتنى العلماء بها، وألفوا فيه المؤلفات، وقد أشار هذه الحديث إلى هذا العلم، بل يمكن أن يُجعل أصلاً في باب علم عدِّ الآي، ووجه الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسَّر السبع المثاني بأنها الفاتحة، وهي سبع آياتٍ.
2 – بناء على تفسيره صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإن الآية {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}(الحجر:87)أصل في علم عدِّ الآي.
وهذا يعني أن بعض أنواع علوم القرآن يمكن إيرادُ أصلٍ لها من الكتاب والسنة، أو من أحدهما.
3– يمكن أن يُستنبط من هذا الموضع أن الإمام البخاري يرى أن الآية السادسة في سورة الفاتحة هي قوله –تعالى–: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ}، وأن ابتداء الآية السابعة بقوله:{غَيرِالمَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}.
وهذا هو عدُّ أهل المدني الأول والمدني الثاني والبصري والشامي. قال الداني (ت: 444): «الحمد... وهي سبع آيات في جميع العدد.
اختلافها آيتان {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ}عدَّها المكي والكوفي، ولم يعدها الباقون.
{أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} لم يَعُدَّها المكي والكوفي، وعدها الباقون».
ومما يشير إلى أن هذا مذهبه أمران:
الأول: أنه كما سبق – فصَل البسملة في أول حديثه عن تفسير الفاتحة، فقال: {الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ}:
اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ، الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، كَالعَلِيمِ وَالعَالِمِ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ»، ففسَّر البسملة، ثم ابتدأ بالفاتحة.
ويساعده على هذا نصُّ الحديث الذي أورده عن أبي سعيد بن المعلى، قال: «... قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ؟
قَالَ: {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ».
ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لبدأ بها،، فبداية السورة فيه {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
الثاني: أنه قال ههنا «بَابُ {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}».، وكأنه يشير إلى أنها جملة آيةٍ واحدة، ولم يكتف بقوله:
{وَلاَ الضَّالِّينَ}، والله أعلم.
* * *
الخاتمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبعد هذا العيش بين بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أصحِّ كتب السنة، ومع نفائس الإمام البخاري ~ لاستنباط مسائل علوم القرآن، ظهر لي حاجتنا الماسة للرجوع إلى هذا الكتاب بالذات لاستخلاص هذه المسائل منه، وللاستفادة منه أجلَّ استفادة؛ إذ فيه كنوز دفينة، فمن أتى إليها بقدر ما عنده من تأسيس في علوم القرآن، ووهبه الله قدرة على الاستنباط، فإنه سيجد ثروة من المعلومات في علوم القرآن تفيده في مجال التطبيق على أنواع علوم القرآن التي ذكرها الأئمة السابقون؛ كالزركشي (ت:794) في كتابه «البرهان في علوم القرآن»، والسيوطي (ت: 911) في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»، وغيرهما.
وأرجو أن أكون قد وُفِّقت في أن يكون هذا المقال أنموذجًا للفكرة التي أردت عرضها. وأسأل الله القبول والتوفيق.
ثم إني بعد كتابة هذا البحث انتهيت إلى عدد من النتائج والتوصيات.
وخلصت إلى عدة نتائج من أهمها:
1 – أن الحاجة ماسة إلى استنطاق الآثار لتعزيز مسائل علوم القرآن وأصول التفسير.
2 – أن الإمام البخاري صاحب اختيار في التفسير.
3 – أن الإمام البخاري استفاد كغيره من المفسرين في باب النقل من مرويات المفسرين ومن كتب اللغويين.
4 – أن الحاجة لا تزال قائمة في إبراز منهج الإمام البخاري زيادة على ما قام به الباحثون، إذ إن هناك ما لم يتم التنبيه عليه عندهم.
وكان من أبرز التوصيات التي ظهرت لي من خلال هذا البحث:
1 – أن يعمد الدارسون لعلوم القرآن وأصول التفسير إلى الجانب التطبيقي من خلال الآثار النبوية وغيرها من تفسيرات الصحابة والتابعين.
2 – أن تخص كتب التفسير من كتب الصحاح والسنن بالدراسة، ففيها فوائد جليلة لا تظهر إلا بالاستقراء والتحليل لهذه الكتب.
3 – أن تتابع الدراسة لمناهج الأئمة المسندين الذي عُنوا بالتفسير من خلال كتبهم التي ليست في التفسير.
هذا ما يسر الله كتابه، والحمد لله رب العالمين.
* * *
ـــــــــــــــــــــ
(1) ذكر مقاتل في كتابه: الوجوه والنظائر المادة رقم (82) النشور في أربعة أوجه، وفي الوجه الثالث ذكر عددًا من النظائر، فقال: «والوجه الثالث: النشر يعني البسط، فذلك قوله في عسق: {وينشر رحمته }(الشورى: 28)، يقول: ويبسط رحمته، وهو المطر؛ كقوله في الكهف:{وينشرلكم ربكم من رحمته}(الكهف: 16)، يقول: يبسط لكم من رزقه، وقال في الفرقان: {وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته} (الفرقان: 48)، يقول: يبسط الرياح والسحاب للمطر، نظيرها في الأعراف. وقال في النمل: {يرسل الرياح بشراً}(النمل: 63)، يبسط السحاب قدام المطر، وقال في الروم: {ثم إذآ أنتم بشراً تنتشرون}(الروم: 20)، يعني: تبسطون». الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان، تحقيق الدكتور عبد الله شحاته (208 ـ 209).
تنبيهان:
1 – جاءت بعض الآيات على غير قراءة حفص.
2 – ينظر في التنبيه على اسم كتاب مقاتل: (التفسير اللغوي للقرآن الكريم) للدكتور مساعد الطيار ح (2)، ص (89 ـ 90).
(2) ينظر: منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال كتاب الصحيح، لسيد أحمد خطري ص (297).
(3) تتميم: اختلف أهل التأويل في السبع المثاني على أقوال:
الأول: السبع السور من أوّل القرآن اللواتي يُعْرفن بالطول. وقد ورد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك.
الثاني: هن آيات فاتحة الكتاب؛ لأنهنّ سبع آيات، وقد ورد عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، ورواية عن ابن عباس، ويحيى بن يعمر، وأبي فاخته، وأبي بن كعب، وأبي العالية. ورواة عن الضحاك، وسعيد بن جبير، وإبراهيم وعبدالله بن عبيد الله بن عمير، وابن أبي مليكة، وشهر ابن حوشب، والحسن. ورواية عن مجاهد، وقتادة، وخالد الحنفي قاضي مرو.
الثالث: أعطيتك سبعة أجزاء: مُرْ، وأنْهَ، وبَشرْ، وأنذِرْ، واضرب الأمثال، واعدُد النعم، وآتيتك نبأ القرآن، وورد عن زياد بن أبي مريم.
الرابع: السبع المثاني هو القرآن العظيم، وورد عن أبي مالك غزوان الغفاري وطاووس اليماني ([1]).
ولا شكَّ أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم@ هو المقدَّم، ويظهر أن من فسَّر بغير تفسيره لم يبلغه التفسير النبوي، فذهب إلى معانٍ صحيحة لو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها قول:
فالفاتحة تسمَّى مثاني؛ لأنها تثنَّى في كل ركعة.
والسبع الطوال مثاني، لأنها تثنى فيه المعاني.
والقرآن كله مثاني، إذ ورد وصفه بهذا في قوله – تعالى -:{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}(الزمر: 23)، والمعاني تُثنَّى فيه.
(4) الاكتفاء في تعريف التابعي بالتقائه بالصحابي هو مذهب جمهور المحدثين. ينظر تفصيله في: تدريب الراوي، للسيوطي (2/263-264).
(5) من أمثلتها ما أشار إليه البخاري - في كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف رِجالًا وركبانًا -، في معنى قوله –تعالى-:
{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ}(البقرة: 239): قال: راجلٌ: قائم. يشير لقول مجاهد في الآية. أشار لذلك الحافظ ابن حجر، ينظر: فتح الباري: (3/245-246).
(6) مثل غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 224)، ينظر: (1/7، 9، 10، 71، 87، وغيرها)، وغريب الحديث، لأبي إسحاق إبراهيم الحربي (ت: 285)، ينظر: (1/4، 25، 59، 130، 163، وغيرها).
(7) ورد ذكر الفراء باسمه يحيى في موضع، قال: «قال يحيى: {وَالظَّاهِرُ} (الحديد: 3): على كل شيء علما، {وَالْباطِنُ}(الحديد: 3): على كل شيء علما».
وذكر أبا عبيدة باسمه في موضع، قال: «وقال معمر: أولياء موالي، وأولياء ورثة».
(8) قاله سيد أحمد الإمام بن خطري: «وقد كان مجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن للفراء متغلغلين في حافظة الإمام البخاري فأفرغ منهما في صحيحه كمية كافية، وتكاد تكون الجوانب اللغوية التفسيرية في الجامع هي مادة الكتابين غير أن البخاري هذَّب كلا منهما واختصره اختصارًا، بيد أنه غلبت عليه الاستقلالية العلمية والنزعة الاجتهادية؛ لذا نراه يخالف أبا عبيدة والفراء من عدم الإكثار من الاستشهاد بالشعر في التفسير، وخالف أبا عبيدة والشافعي في كون القرآن يحتوي على ألفاظ غير عربية». رسالة ماجستير (منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال كتاب الصحيح) ص (403).
وهذا الكلام فيه نظر، فالبخاري لم يهذِّب كلامهما، كما هو المعروف من الحال في التهذيب، وإنما كان ينتخب من كتابيهما ما يصلح له في صحيحه، ولم تظهر من خلال ذلك تلك النزعة الاستقلالية الاجتهادية التي يشير إليها الباحث، وعدم إكثاره من الشعر لا يعني عدم موافقته لهما، بل لطبيعة كتابه، فهو ليس كتاب تفسير كما هو المعهود من كتب المفسرين، وإنما هو في المسند إلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم، فكيف يريد منه الباحث أن يكون مع الاستشهاد بالشعر أو غيره كالتوسع في مسائل اللغة والنحو وغيرها، وهل سيؤاخذه عليها لتركه لها، أم سيجعلها محمدة له كما فعل هنا؟.
ولاشكَّ أن الأمر لا يعدُّ من هذا ولا من ذاك، والصحيح أن البخاري في هذا ناقلٌ في أغلب أحواله، ثقة منه بالمنقول عنهم من جهة اللغة، وليس وراء ذلك سِرٌّ آخر، والله أعلم.
(9) كان الطبريُّ كوفيًّا في أصوله النحوية اللغوية، وكان يُجِّل كتاب معاني القرآن للفراء (ت: 207)، وقد نقل منه كثيرًا، وكان ينسب نقله عنه تحت رسم «بعض نحويي الكوفة»، لكنه لم يكن يرض قوله إذا خالف السلف الكرام، ينظر تفسيره لقوله – تعالى -: {لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً} (الغاشية: 11). وأما أبوعبيدة فقد نقل عنه كثيرًا تحت رسم «بعض لغويي البصرة»، وكان يعترض عليه في بعض تفسيراته اللغوية، ينظر تفسيره لقوله تعالى:{وَفِيه يَعْصِرُونَ}(يوسف: 49).
(10) أما كتاب الفراء فهو أحد مصادر الثعلبي من كتب المعاني في تفسيره، وقد رواه بسنده عن الفراء، ونسخته هي نسخة السُّمَّري المطبوعة، مقدمة الكشف والبيان (110). وأما كتاب مجاز القرآن فجعله في كتب الغريب والمشكلات، وروه بسنده عن أبي عبيد، مقدمة الكشف والبيان (117). مقدمة الكشف والبيان، للثعلبي.
(11) لا يخفى على من يطلع على صحيح البخاري؛ اختلاف النسخ في حكاية مثل هذا، وما ذكرته هو على أحد هذه النسخ، وإلا فإن في بعضها (باب تفسير سورة المائدة).
(12)مما ورد عنه من هذا، ما أسنده في سورة الإسراء، قال: «سورة بني إسرائيل:
حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت عبدالرحمن بن يزيد، قال: سمعت ابن مسعود >، قال: «في بني إسرائيل، والكهف، ومريم: إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي».
(13) لم يكن من عناية البخاري التعليل لأسماء السور، وإنما أورد هذا التعليل في سورة الفاتحة تبعًا – فيما يظهر – لأبي عبيدة معمر بن المثنى الذي قال في موطنين:
الأول: «ولسور القرآن أسماء: فمن ذلك أن «الحمد لله» تسمّى «أم الكتاب»، لأنه يبدأ بها في أول القرآن، وتعاد قراءتها، فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة، ولها اسم آخر يقال لها: فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في المصاحف، فتكتب قبل القرآن». مقدمة مجاز القرآن (1/5).
والثاني: «أمّ الكتاب: مجاز تفسير ما في سورة «الحمد» وهى «أم الكتاب»؛ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف قبل سائر القرآن، ويبدأ بقراءتها قبل كلّ سورة في الصلاة ». مجاز القرآن (1/20).
قال ابن حجر: «وسميت أم الكتاب أنه «بفتح الهمزة» يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة». هو كلام
أبي عبيدة في أول مجاز القرآن، لكن لفظه: ولسور القرآن أسماء، منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بها في أول القرآن، وتعاد قراءتها، فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة، ويقال لها: فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في المصاحف، فتكتب قبل الجميع انتهى». فتح الباري (8/156).
(14) قال القرطبي: «اختلفوا أهي مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياحي، واسمه رفيع وغيرهم: هي مكية. وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري وغيرهم: هي مدنية. ويقال: نزل نصفها بمكة، ونصفها بالمدينة. حكاه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي في تفسيره. والأول أصح؛ لقوله – تعالى -:{ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}(الحجر:87)، والحجر مكية بإجماع». الجامع لأحكام القرآن (1/115).