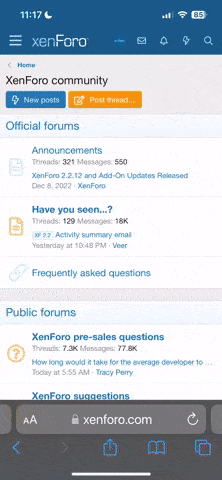عمر السنوي
New member
التَّعْلِيق علَى قاعِدَةِ الشَّيخ مَخلُوف
فِي تَفْسِير الصِّفاتِ والحُرُوف
فِي تَفْسِير الصِّفاتِ والحُرُوف
عمر السنوي الخالدي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيِّين، وعلى آله وصحبه والتابعين.
أما بعد:
فقد اطلعتُ على كلامٍ لسماحة الشيخ حسنين محمد مخلوف - رحمه الله وغفر له - في مقدِّمَة تفسيره: «صفوة البيان لمعاني القرآن» - في فصْلٍ مُفرَدٍ يشتمل على مسائل ينبغي معرفتها - من وجهة نظَره -، ويعنينا منها هنا المسألة الرابعة: (في المُحكم والمُتشابِه)؛ فقد ذكَر فيها الشيخُ تَعريفاتٍ مختلفة لمصطلح المحكم والمتشابه، ويبدو أنّه رجَّحَ التعريف الأول الذي أورَدَه بصيغة الجزم، بخلاف غيره من التعريفات التي أوردها بصيغة التضعيف، ويؤيِّدُ ذلك تطبيقُه لهذا التعريف على قضيتين من قضايا القرآن الكريم، هما: (صفات الله تعالى) و(الأحرف المقطّعة أوئل السوَر).
أما التعريف الذي جزم به؛ فهو أنّ المحكم «ما عُرِف المراد منه»، والمتشابه «ما اسْتَأثر الله بعلمه». ومَبنَى هذا التعريف وقْفُ القائلين به على كلمة (الله) في آية: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ﴾ [آل عمران: 7]، وقالوا بأنّ الواو في (والراسخون) هي واو الاستئناف لا العطْف.
وهذا التعريفُ لا يَقْوَى على مواجهة النصوص القاضيةِ بخلافه - كما سأتي -.
وأما ما ذكَرَه الشيخُ مخلوف أنّ الخطّابيَّ جعلَ المتشابِه على ضَرْبَين: متشابِهٌ يُرَدُّ إلى المُحكَم فيُعلَم معناه، ومتشابِهٌ لا يمكن التوصّل إلى معناه ولا يعلمه إلا الله؛ فهذا وهْمٌ في فهْم كلام الخطابيِّ، إذْ الذي أوْرَدَه الشيخ مخلوف يختلف نصُّه عمّا نقلَه عنه السيوطي في «الإتقان» (1/ 646)، حيث قال: «المتشابه على ضربَين: أحدهما ما إذا رُدَّ إلى المحكَم واعْتُبِرَ بهِ عُرِفَ معناه، والآخَر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتّبعه أهل الزيغ فيطْلبون تأويلَه، ولا يبلغون كُنهَه، فيرتابون منه فيُفتَنون».
ويظهَر من هذا أنّ الضرْبَ الآخَر ليس فيه نفيُ علْم (معنى الآيات)، ولذلك حملَه أهل العلم على أنّ المراد به نفي علْم (مآل الآيات)، أي: حقيقة ما يَؤُولُ إليه الأمْر، وهو معنىً صحيح في لغة العرب، وقد استعمله القرآن، كما في آية: ﴿ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ [يوسف:36] يعني: مآل الأمر ووقوع الرؤيا، وهذا المعنى هو اختيار شيخ المفسِّـرين الطبري رحمه الله في «تفسيره» (6/ 200) مُرجِّحاً ما رواهُ عن حَبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. مثال ذلك: معرفة وقت المغيّبات: كانقضاء المدة وقيام الساعة، وحقائق صفات الله - جل وعلا -، ونحو ذلك مما لَه تعَلُّقٌ ببابِ العقيدة وليس له تعَلُّقٌ بعلْم التفسير.
وعلى هذا الفهم لكلام الخطابي والطبري يكون الوقْف في هذه الآية على كلمة (الله) وقْفٌ سليم، لا يفيد عدم إدراك أهل العلم الراسخين لمعاني الآيات المتشابهة، فليسَ في القرآن لَفظٌ لا يعلَم معناه إلا الله.
أما المعنى المراد في الضرب الأول من كلام الخطابي: فهو مرادفٌ للتفسيرِ ومقاربٌ له في المعنى. وهذا أيضاً دلّت عليه لغة العرب، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»[1].
وأما النصوص الدالّة على أنّه ليسَ في القرآن لَفظٌ لا يعلَم معناه إلا الله، فمنها:
قول الله تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ﴾ [ص، 29] وقوله: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ [النساء:82]، فلو أنّ في القرآن ما لا يُعقَل معناه لم يكن بالإمكان تدَبُّرُه، فهذه الآية تدلّ على أن القرآن (كلّه) نحن مأمورون بتدبُّرِه، وأنّ بالإمكان إدراك معانيه.
وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: 19]، فهذا عام في جميع آيات القرآن، فمن وقفَ على الدليل فقد أفْهمَه الله مرادَه مِن كتابه، وهو أكمل ممن لم يقف على ذلك، إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون[2].
وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾[الزخرف: 44]، فهذه الآية تدلّ على أنّ الله تعالى سائلنا عن القرآن، مما يعني استحالة أن يسألنا الله عن شيءٍ لا يمكننا إدراك معناه، وإلا لم يكن ليحاسبنا عليه.
وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديث حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله»[3].
كما أنّ من العبَث - الذي ننزه عنه اللهَ عز وجل وكتابَه - أنْ يُنزل إلينا شيئاً لا نفهمه ولا نعقل معناه.
ولذلك يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (13/ 285): «إنَّ الصحابة والتابعين لم يَمتنِع أحدٌ منهم عن تفسيرِ آيةٍ من كتاب الله، ولا قالَ هذه مِن المتشابه الذي لا يُعلَم معناه، ولا قالَ قطّ أحدٌ من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين إنّ في القرآن آياتٌ لا يُعلَم معناها ولا يَفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم والإيمان جميعاً؛ وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس وهذا لا ريب فيه».
وبناءً على ذلك التعريف الذي اعتمده الشيخ مخلوف، فقد جعلَ قضية (صفات الله العليا) من المتشابه الذي لا يعلَم تأويله إلا الله، وصرَّح بأنَّه يقصد بذلك نفيَ علْم المعنى وليس نفي علْم الحقيقة أو الهيئة أو التصوّر أو الكيفية، حيث قال: «يجب الإيمان بها وتفويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى، وترك تأويلها» ناسباً هذا الرأي إلى: جمهور أهل السنة والسلف - عموماً -، ثم ذكر منهم: أم سلمة رضي الله عنها، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وابن المبارك، ووكيع، والأئمة الأربعة، ومحمد بن الحسن، وابن الصلاح، وابن تيمية، وابن القيم...
وهذا وهْمٌ شديد، لعله تلقّاه عن الجويني والرازي، فقد أورَدَ كلامهما في ذلك.
قال أبو المعالي الجويني في «العقيدة النظامية» (ص32): «ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه. والذي نرتضيه رأياً، ونَدين الله به عقداً: اتباعُ سلف الأمة... وقد درج صَحْبُ الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك التعرّض لمعانيها، ودرك ما فيها».
وقال الرازي - فيما نقله عنه السيوطي في «الإتقان» (3/ 14) -: «ولذا اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف أنّ بعد إقامة الدليل القاطع على أنّ حمل اللفظ على ظاهره مُحال لا يجوز الخوض فى تعيين التأويل». ولم أجدْ في تفسير الرازي لفظ: (اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف)، فالعهدة على السيوطي.
فلنختبر - الآن - حقيقة زعمهم أنّ هذا هو مذهب السلف والأئمة:
أورَدَ الشيخ مخلوف أثر أم سلمة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى ﴿ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش ﴾ [طه: 5]، قالت: «الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والحجود به كفر»[4].
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/ 365): «وقد رُوي هذا عن أمِّ سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يُعتمد عليه»، وقال الذهبي في «العلوّ» (ص65): «فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ لأنَّ أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه».
ولكن الشيخ مخلوف أورَدَ مثله عن مالك بن أنس رحمه الله، وهو صحيح ثابت مرويّ من طرقٍ عِدة، وقد أفردَ له د.عبدالرزاق البدر رسالةً بعنوان: «الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء: دراسة تحليلية».
والناظر في هذا الأثر عن مالك، لا يجد فيه نفياً لمعنى صفة (الاستواء)، بل على العكس، فإنّه يجد فيه إثباتاً بصريح المقال: أنّ المعنى غير مجهول لدى السلف. وهذا الأثر من أشهر الآثار في الردّ على المفوّضة، فمن الغريب أن يستدلّوا به على باطلهم.
أمّا ما ذكره الشيخ مخلوف عن محمد بن الحسن الشيباني، أنه قال: «اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ مِن الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ عَلَى الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الثِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صِفَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ: مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ، وَلَا وَصْفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ؛ فَمَنْ فَسَّرَ الْيَوْمَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ خَرَجَ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَصِفُوا وَلَمْ يُفَسِّرُوا؛ وَلَكِنْ أَفْتَوْا بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ثُمَّ سَكَتُوا؛ فَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ جَهْمٍ فَقَدْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ لِأَنَّهُ قَدْ وَصَفَهُ بِصِفَةِ لَا شَيْءَ»[5]؛ فهذا الأثر ليس فيه دلالة على نفي العلم بمعاني الصفات، وإنما فيه نفي التحريف والتشبيه وتفسير حقائق الصفات وكيفياتها، وإلا فإنّ المعنى معلوم، يفقهه العرب، ولكن لا يمكن أن يدركوا حقيقته لأنه من الغيب، ولأنه متعلّق بالرب جل وعلا، الذي يُدرِك الأبصار ولا تدركه الأبصار. لذلك قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/ 50) تعليقاً على هذا الأثر: «وَقَوْلُهُ (مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ): أَرَادَ بِهِ تَفْسِيرَ الْجَهْمِيَّة الْمُعَطِّلَةِ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا تَفْسِيرَ الصِّفَاتِ بِخِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ مِن الإثْباتِ».
وأما ما نقلَه الشيخ مخلوف عن ابن الصلاح أنه قال: «على هذه الطريقة مضـى صدر الأمة وساداتها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها، وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه» والشيخ كثيراً ما ينقلُ عن السيوطي دون عزو، فقد راجعت «الإتقان» للسيوطي ولم أجد سوى هذه القطعة من نَص كلام ابن الصلاح؛ فما هي الطريقة التي أشار إليها ابن الصلاح هنا؟
ولمعرفة مراد ابن الصلاح لا بدّ من معرفة سباق الكلام وسياقه، فنَصُّه كما نقله عنه الزركشـي في «البحر المحيط» (5/ 40): «الناس في هذه الأشياء الموهِمة للجِهَة ونحوها فرَق ثلاث: ففرقة تؤوِّل، وفرقة تشبِّه، وثالثة تَرى أنه لم يُطلِق الشارع مثل هذه اللفظة إلا وإطلاقه سائغ، وحسُنَ قَبولها مطلقةً كما قال، مع التصـريح بالتقديس والتنزيه، والتبرّي عن التحديد والتشبيه، وعلى هذه الطريقة مضـى صدر الأمة وساداتها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها، وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه».
إذَن؛ فالطريقة التي امتدحها ابن الصلاح ونسبَها إلى أهل الحديث والأئمة والفقهاء هي الطريقة التي ليس فيها تشبيه، ولا فيها تعطيل، وإنما فيها إثبات لما جاء في نصوص الوحي بمعانيه الظاهرة الحسنة المعلومة، مع تنزيه الله عز وجل عن التكييف أو التشبيه.
إلى هنا تنتهي النُّقول الّتي نقلها الشيخ مخلوف؛ أما بقية الأسماء فقد ذكرَها ذِكْراً ونسَبَ إليها القولَ بتفويض المعنى إشارةً دون نقلٍ صريح ولا إحالةٍ إلى مَصدر!
ولذلك فإنّ الردّ العلمي يقتضي تتبّع ذلك وإيراد ما ينقض هذ الزعم، فأقول:
أولاً: إنّ قائد السلف هو النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قد ورَدَ عنه ما يفيد بيان معاني هذه الصفات على المعنى المعروف في لغة العرب، من ذلك ما ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنّه كان يقرأ ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58] ويضعُ إبهامَهُ على أذُنِه والتي تَليها على عينِه، قال ابنُ يَزيد المُقرِئ - أحدُ رجالِ السَّند في هذا الحديثِ -: «يعني أنَّ للهِ سَمعاً وبصَراً»[6].
ثانياً: قد ثبت عن بعض الصحابة - وهم سادة السلف - ما يفيد بيان معاني هذه الصفات على المعنى المعروف في لغة العرب، من ذلك - مثلاً -: قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّك ﴾[الفجر:22] «فيجيء الله فيهم والأمم جثيّ»[7].
ومثل ذلك ما ورَدَ عن بعض التابعين، ومنه: قول مجاهد: «﴿ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش ﴾[طه:5] أي علا على العرش». ومثله قول أبي العالية: «استوى أي ارتفع»[8].
ثالثاً: ما أشار إليه الشيخُ بأنه مذهبُ الثوري، فلعله أراد ما روي عنه أنه قال: «أفهمُ من قوله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾[طه: 5]: ما أفهم من قوله ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [فصلت: 11]»، ففي قوله هذا إثباتٌ بأنَّه فهِم منها شيئاً، وأنّها ليستْ مما لا يُفهَم ولا يُعلَم معناه. علماً أنّ هذا الأثر قد ذكره غير واحد، ولم أجده مُسنَداً.
رابعاً: ما أشار إليه الشيخُ بأنه مذهب ابن عيينة وابن المبارك، فلعله أراد ما روي عنهم أنهم قالوا في أحاديث الصفات: أمرّوها بلا كيف.
فالنفيُ صريحٌ - هنا - بأنه نفيٌ لعلْم الكيفية لا المعنى، ولذلك رُوي عن ابن المبارك - نفسه - أنه قال لمن سأَلَه: كيف نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه»[9]. فلولا أنه يعرف المعنى لما أجاب بهذا الجواب رحمه الله.
خامساً: ما أشار إليه الشيخُ بأنه مذهب الأئمة الأربعة، فهذه أقوالهم:
قال أبو حنيفة كما في «الفقه الأبسط» (ص56): «لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته، ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم، ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه».
وقال - أيضاً - كما في «الفقه الأكبر» (ص302): «وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن، من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطالَ الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال...».
وقال مالك: «الله في السماء، وعلمه في كل مكان»[10]. فإنّ مالكاً - هنا - يقرر مقولته الشهيرة في أنّ الاستواء غير مجهول وأن الكيف غير معقول.
وقال الشافعي: «نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن، ووردت بها السنة، وننفي التشبيه عنه، كما نفى عن نفسه، فقال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى:11]»[11]. إذن؛ هذا هو مذهبه: الإثبات، لا التفويض.
وقال أحمد: «نحن نؤمن بأن الله على العرش، كيف شاء، وكما شاء، بلا حد، ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد؛ فصفات اللهِ منه وله، وهو كما وصف نفسه، لا تدركه الأبصار»[12]. وسيمرّ معنا كلام آخَر - له - ضمن تقريرات ابن تيمية.
أما ما يُروى عن أحمد أنّه قال: «نؤمن بها ونصدّق بها، ولا كيف ولا معنى»، فهذا من رواية حنبل بن إسحاق، وقد قال عنه الذهبي في «السيَر» (13/ 52): «له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد ويغرب». وقال ابن القيم في «الصواعق» (ص406): «وهو كثير المفاريد المخالِفة للمشهور من مذهبه». علماً أنّ اللالكائي قدْ رواها دون هذه اللفظة في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (3/ 453).
سادساً: ما أشار إليه الشيخُ مخلوف بأنه مذهب ابن تيمية وابن القيم، فهذا من أبعد ما يكون، فقد صرَّحا في كتبهما بخلاف ذلك، وأغلظا القول في الردّ على المفوّضة. والسبب في أنّ كلامهما كان صريحاً واضحاً أصرح من قول المتقدّمين من السلف والأئمة: هو أنّ التفويض في المعاني إنما نشأَ متأخِّراً، فاحْتاجا إلى رَدّه بعبارة واضحة تُبطل ما أُحْدِث مِن نسبة تفويض المعاني إلى السلف، وتُثبت أنّ التفويض الذي أراده السلف هو تفويض الكيفية وحقيقة الهيئة.
وكلامُ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مسألة إثبات معاني الصفات والرد على المفوّضة: كلامٌ كثير، سأكتفي بنقلٍ واحدٍ عن كلٍّ منهما وإن كان فيه نوعُ تطويل، إلّا أنّه جدّ مهمّ:
قال ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 201 - 207): «وأما التفويض فإنّ من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ وأيضاً، فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا، وإخراجنا من الظلمات إلى النور، إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر، ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه، أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك، فعلى التقديرين لم نخاطَب بما بيَّن فيه الحق، ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر، وحقيقة قول هؤلاء في المخاطِب لنا: أنه لم يبيِّن الحق، ولا أوضحه، مع أمره لنا أن نعتقده، وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه، بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا أن نفهم منه شيئاً، أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه؛ وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد... وما ذكرناه من لوازم قول التفويض: هو لازم لقولهم الظاهر المعروف بينهم، إذ قالوا: إن الرسول كان يعلم معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة، ولكن لم يبين للناس مراده بها، ولا أوضحه إيضاحاً يقطع به النزاع! وأما على قول أكابرهم: إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله، وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها؛ فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة، ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن، أو كثير مما وصف الله به نفسه، لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه... ومعلوم أن هذا قدْح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن، وأخبر أنه جعله هدىً وبياناً للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه لا يعلم أحد معناه، فلا يُعقَل ولا يُتدبَّر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلّغ البلاغ المبين! فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
فإن قيل: أنتم تعلمون أن كثيراً من السلف رأوا أن الوقف عند قوله ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 7]، بل كثير من الناس يقول: هذا هو قول السلف... وما ذكرتموه قدْح في أولئك السلف وأتباعهم. قيل: ليس الأمر كذلك، فإن أولئك السلف الذين قالوا: لا يعلم تأويله إلا الله، كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم، ولم يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معنى التأويل الاصطلاحي الخاص، وهو صرف اللفظ عن المعنىالمدلول عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف ذلك، فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلاً إنما هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم، ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، لاسيما ومن يقول إن لفظ التأويل هذا معناه، يقول: إنه يحمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به. وهؤلاء يقولون: هذا المعنى المرجوح لا يعلمه أحد من الخلق، والمعنى الراجح لم يُردْه الله. وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله بلفظ التأويل في مثل قوله تعالى ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ [الأعراف: 53]... وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنها، وذلك في حق الله: هو كُنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. وكذلك كان ابن الماجوشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن علمنا تفسيره ومعناه... وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن، وكانوا يقولون: إن العلماء يعلمون تفسيره وما أريد به، وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه».
وقال ابن القيم رحمه الله في «الصواعق المرسَلة» (2/ 422): «والصنف الثالث: أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تُعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظاً لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله... فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معناه وننكِر على من تأوّله، ونَكِل علمه إلى الله. وظنَّ هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى... نصوص الصفات. وبنوا هذا المذهب على أصلين:
أحدهما: أنّ هذه النصوص من المتشابه.
والثاني: أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله.
فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأنهم كانوا يقرؤون [نصوص الصفات] ويَرْوُونَـ[ـهَا] ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أُريدَ به! ولازم قولهم أنّ الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلَم معناه! ثم تناقضوا أقبح تناقض، فقالوا: تُجرى على ظواهرها، وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل ومع ذلك فلها تأويل لا يعمله إلا الله، فكيف ثبتون لها تأويلاً ويقولون تجرى على ظواهرها ويقولون الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعلم تأويلها!! وهل في التناقض أقبح من هذا؟!
وهؤلاء غلطوا في المتشابه، وفي جعل هذه النصوص من المتشابه، وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله؛ فأخطأوا في المقدمات الثلاث، واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين وسدوا على نفوسهم الباب وقالوا: لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب. فهؤلاء تركوا التدبّر المأمور به والتذكّر والعقْل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين، وأعرضوا عنه بقلوبهم، وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقّل معانيها وتدبّرها والتفكّر فيها. فأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخييل أمثالاً لا حقيقة لها».
بعد هذا التوضويح والبيان، يمكن استنتاج أنّ آيات الصفات من حيث فهم معانيها ومعرفة دلالاتها هي من الآيات المحكمات اللاتي هنّ أمّ الكتاب.
أما من حيث المآل وحقيقة الكيفية فهي من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله، وهي تختلف عن الغيبيات الأخرى لتعلّقها بذات الله، فالله جلّ في علاه لا يمكن إدراك ذاته وحقيقة صفاته، فهو الربّ سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فمن قال مِن أهل العلم بأن التأويل معناه ما يؤول إليه الأمر: فإنّ كيفية هذه الصفات وحقيقتها من هذا المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا خارج عن دائرة علم التفسير.
هذا، وقد أشار الشيخ مخلوف في آخر كلامه عن نصوص الصفات إلى أنّ هناك طائفة من أهل السنة قالوا بتأويل الآيات والأحاديث الواردة في الصفات بما يليق بالله تعالى - في ظنّهم -، مع تنزيهه عن حقيقتها - على حدِّ قوله -! أي: أنهم صرفوها عن ظاهرها! واصفاً قولهم بأنّه قول الخلَف. وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أنَّ قولهم مُحدَث ومبتَدَع، وأنّ صَرْفَهم للآيات عن ظواهرها يخالِف عمَل الرسول وأصحابه وأئمة السلف ومَن تبعهم، كما أنّه مخالِف لِلُغةِ العرب، وهو ناشئ عن توهُّمِ لزوم القول بالتشبيه والتمثيل والتجسيم حال إثباتها على ظاهرها، وهذا غير لازمٍ لغةً ولا شرعاً ولا عقلاً.
بقي أن أشير إلى ملحَظ آخَر حول موقف الشيخ مخلوف من نصوص الصفات، فعلى الرغم من أنه قعّدَ في مقدّمته قاعدة التفويض ونصَرَ القول بها، إلا أنّ القارئ لتفسيره يجده يؤوِّل في عددٍ من المواضع، ويحيد عن قاعدته التي تلزمه بعدم التعرّض لمعناها! ولعلّ الله ييسِّـر التنبيه عليها في مقام آخر، فهي كثيرة، والله المستعان.
أما القضية الأخرى من قضايا القرآن، فهي قضية (الحروف المقطَّعة) أوائل التسع والعشـرين سورة من سوَر القرآن الكريم، فقد قال الشيخ مخلوف بأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وأنّها من أسراره.
وهذا القول وإن كان قد قال به بعضُ أكابر المفسِّرين، إلا أنّ الأدلّة التي سبق تصدير هذا المبحث بها في وجوب تدبّر القرآن والتفكّر في آياته، والتعقّل لمعانيه وإحسان فهمه والغوص لاستخراج أسراره، وأنّ العباد مسؤولون ومحاسبون على ذلك أمام الله تعالى: تشمل هذه الأحرف المقطّعة - أيضاً -.
ولذلك نجد جمهور المفسرين على مرّ القرون قد تعرّضوا لها إما بالتأويل أو بالكشف عن أسرارها وبيان الحِكْمة منها، ولن يتوقَّف هذا ما دام على الأرض مَن يشهد أن (لا إله إلا الله محمد رسول الله).
وقد فرَّق الشيخ مخلوف بين بيان معاني هذه الحروف وبين الكشف عن حكمتها، فجعل الأوّل مما استأثر الله بعلمه، والثاني مما يمكن للعباد علمه ومعرفته. والحقُّ أنَّ بيان الحكمة منها هو فرع عن تأويلها، فيَلزَم القائل "إنّ المتشابه لا يَعلَم تأويله إلا الله - فحسب - " أنْ يتَوقَّف عن الكلام في حكمة إيراد هذه الحروف وأسرارها.
ولهذا فإن أهل البلاغة قد تفننوا في بيان أسرارها، وما ذلك منهم إلا نوع من العمل على تأويلها. وليس المقام هنا مقام سردٍ لهذه الأقوال والاجتهادات؛ ولكن تكفي الإشارة إلى أنّ هذه الحروف ما زالت تنال عناية الباحثين من أهل اللغة والتفسير، وما زالت الجامعات تنتج الدراسات الأكاديمية حولها، وأُفردت لها المصنّفات قديماً وحديثاً.
فعلى المسلم أنْ يتدبَّر كلام ربِّه عزَّ وجلَّ، ويسعَى في الكشف عن أَسراره، ويجتهد في الغوص على دُرره، علَّ الله تعالى يُعيد لهذه الأمة مجدَها ويُعينها على نهضتها.
-----------------
[1]رواه أحمد بن حنبل (2397)، وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح».
[2]كما قال العز بن عبدالسلام فيما نقله الزركشي عنه في «البحر المحيط» (5/ 41).
[3] رواه مسلم (147).
[4] رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (3/ 497) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (3/ 164).
[5] رواه - بطوله - اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (3/ 432)، وذكرَه الشيخ مخلوف مختصراً.
[6] «الصَّحيح المسنَد ممَّا ليس في الصَّحيحَين» (1252).
[7] رواه الطبري في «تفسيره» (30 / 118).
[8] رواهما البخاري تعليقاً، ووصَلَهُما ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ 344).
[9] رواه الدارمي في «كتاب الرد على الجهمية» (ص23).
[10] رواه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (ص263)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ص11)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (7/ 138).
[11] انظر: «السير» للذهبي (20/ 341).
[12] انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (2/ 30).