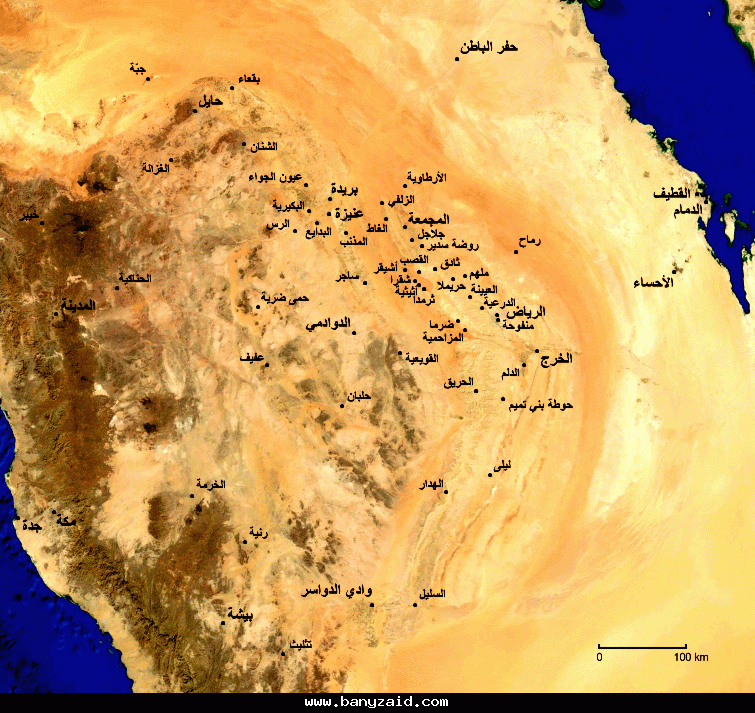إبراهيم الحميضي
Member
رأيي في تلاوة الشيخ عبدالباسط.. وشيء من هموم التلاوة واللغة
كتبه أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري
مقال منشور في جريدة الجزيرة يوم الخميس 23/4/1428 وفيه بعض الفوائد واللطائف. على أني لا أتفق مع الكاتب الكريم في بعض الأمور التي ذكرها.
الشيخ عبدالباسط بن محمد بن عبدالصمد -رحمه الله- من أحلى المقرئين صوتاً بإطلاق وأطولهم نفساً.. إلا أن لي بعض الملاحظات على تلاوته بعد قليل إن شاء الله، ولهذا نُسي، واستبدل به ذوو التلاوة المجودة منذ الشيخ الحذيفي إلى شبابنا حفظهم الله.. ولد رحمه الله سنة 1346هـ- 1927م، وتوفي سنة 1409هـ- 1988م، وهو شيخ المقرئين المصريين، ورئيس نقابة قراء ومحققي القرآن الكريم في مصر، وعضو المجلس الأعلى الإسلامي، وكان والده من أكراد العراق.. حفظ القرآن ولم يتجاوز العاشرة من عمره - فليعتبر شباب العصر-، وأتقن القراءات السبع ولم يتجاوز أربعة عشر عاماً(1).
قال أبو عبدالرحمن: ولا تزال ترتبط ذكرى تلاوة عبدالباسط بذهني ووجداني في صغري أيام الراديو الفيلبس الكبير الذي نشغله على البطارية، ويستفتح بصوته الإذاعات؛ فكنا نصغي إليه عند وجبة الفطور قبل الذهاب إلى المدرسة، وهكذا تستقبلنا نوافذ المربع بالرياض إذا زرناه في العطلة، حيث يسكن بعض أصدقاء الوالد -رحمه الله- في غرف بالمربع؛ فلا تسمع إلا صوت عبدالباسط بأعلى ارتفاع من صوت الراديو؛ وكان أخي عبدالله -رحمه الله- مشهوراً في شقراء بالإجادة المطابقة لصوت عبدالباسط عبدالصمد مع انقطاع قليل في النفس، كما كان يقلد المنشاوي، ومحمد رفعت، ومحمود خليل الحصري، وأبوالعينين شعيشع.. وكان الوالد -رحمه الله- يذهب به إلى مرقده في الموعد المحدد على الرغم منه؛ لأنه يقضي الليل في تحريك مفتاح الراديو يميناً وشمالاً يتحرى كل إذاعة تستفتح بتلاوة أحد هؤلاء.. وأمثل القراء المصريين المشهورين تجويداً المنشاوي، ومحمد محمود الطبلاوي، ومحمود خليل الحصري، ومحمد رفعت، وأبوالعينين شعيشع.. ذكرتهم على الترتيب في الإجادة، والطبلاوي طويل النفس، متقن للتجويد بلا تكلف، موفق في نطق الحروف من مخارجها.. إلا أنه مثل أكثر المقرئين -إذا لم تكن أشرطته مدبلجة.. أي محذوفة السكتات- لا يقف للدعاء والاستعاذة والتسبيح عند آيات الترغيب والترهيب والتقديس؛ فيفوته أجر ذلك، ولكن المستمع لن يغفل عن ذلك؛ لأن تلاوته تقتضي الخشية، وهذه خصيصة له وحده بينهم، والحصري دونه في التجويد ولم يرزق حلاوة صوت، وأبوالعينين أحلاهم صوتاً، ويضارع الطبلاوي في طول النفس؛ إلا أنه يقف كثيراً عند كل آية أو جزء من آية وإن لم يكن فيها ما يقتضي التسبيح أو الدعاء أو الاستعاذة؛ بسبب تكلفه في رفع الصوت؛ فيأخذ نفساً طويلاً، وقد يخفض الصوت؛ فلا تكون تلاوته على وتيرة واحدة.. ويشترك مع محمد رفعت في أنهما يميلان إلى التحزين ولا تتبين تلاوتهما أحياناً؛ فهما أكثر تكلفاً في التجويد والتحزين.. إلا أن محمد رفعت أحلى صوتاً، وأقرب إلى التحزين شبه الطبيعي إلا في تلاوة له لسورة (اقتربت الساعة)؛ فقد تكلف التحزين.. والطبلاوي يراعي النبر العروضي أحياناً وهو إظهار التعجب والإنكار والتساؤل.. الخ.. والملاحظ على عبدالباسط رحمه الله ما يلي:
1- أنه ينبغي التثبت من القراءات التي يقرأ بها؛ فإنه قرأ في سورة الغاشية (بمضيطر) بضاد معجمة بعد الميم، ولا تعرف هذه القراءة عن أحد، وإنما ورد في قراءة لا يعتد بها نقلا إشمام الصاد زاياً، وهذا الإشمام(2) (مع عدم إمكانه) لا يقتضي النطق بالضاد.
قال أبو عبدالرحمن: والعجب تصحيحها عند بعض النحاة وفي كتب بعض القراءات، وأرى أن إشمام الصاد زاياً ليس من الحروف الفرعية؛ لأنه محال النطق به، وما كان محالاً فليس حرفاً.. وهذه الإحالة بالنسبة للآية من سورة الغاشية (بِمُصَيْطِرٍ)؛ قراءة تفرد بها خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي: عن سليم بن عيسى: عن حمزة رحمهم الله تعالى، والظاهر أنه سمعها بتصرف في الصاد بأن جعلها ساكنة وأتمها بزيادة زاي مكسورة.. ولا يمكن أن يتصور إشمام الصاد زايا بغير هذه الصورة؛ لأن طبيعة الصوت البشري بمخارجه لا يوجد حرف فرعي بين الصاد والزاي مثل الكاف في (كيف حالك؟) في عامية نجد، فلها في الصوت البشري مخرج بين الجيم والكاف، وهكذا (الصِّرَاطَ).. يستحيل أن تجد له مخرجاً بين الصاد والزاي، ومحال أن تجد له شمامة بين الصاد والزاي بخلاف الصاد والسين فإنك تخفف نطق الصاد فلا تلفظ بها من مخرجها خالصة، بل تميل إلى السين أيضاً من دون أن تلفظ بها خالصة من مخرجها، وهذا تكلف متعب، وأما ما بين الصاد والزاي فهو محال.. والتقارب اللغوي بين معاني صراط وسرط وزرط لا يسوغ نطقاً متكلفاً أو دعوى نطق محال، وإنما يتصور نطق الصاد ساكنة بعدها زاي مكسورة، وهذا تصرف في حرف الصاد، وزيادة حرف زاي، ولا يقبل في كلام الله إلا ببرهان قوي.. وحمزة هو الإمام حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي -رحمه الله تعالى- من أئمة القراءات السبع، ولكن هذه القراءة عنه ليست سبعية؛ لأن راويها عن تلميذه سليم هو خلف بن هشام -رحمه الله- إمام من القراء العشرة؛ فعلى فرض صحة الممكن (الذي أسلفته من إشمام الصاد زاياً) عن سليم؛ فيكون سليم -وإن كان أقوم تلاميذ حمزة بحرفه- منفرداً عن بقية تلاميذ حمزة، ولكن الأظهر -لإحالة الإشمام، والاحتياج إلى إسكان الصاد وإتمامها بزاي مكسورة- أنها لا تثبت عن سليم وإن كان راويها خلف إماماً لأمور:
أولها: أن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- كره قراءة حمزة؛ فلما بحث عن السبب وجد أنه انفراد بعض القراء بالرواية عنه؛ فأحد الرواة عن سليم عن حمزة سمع مقرئاً يروي قراءته عن حمزة وفيها إفراط في المد؛ فكره ابن إدريس ذلك.. ومعنى هذا أنها لم تثبت عن حمزة؛ لأن أبا عمارة حمزة -رحمه الله- كان يقول ناهيا لرجل: (أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق الجعودة فهو قطط(3)، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة)(4).
وثانيها: أن هذا الانفراد عن أصحاب سليم بن عيسى تلميذ حمزة، وهذا الانفراد عن بقية تلاميذ حمزة في أمر محال أو تصرف متكلف: قاض بترجيح الاحتمالات القاضية بردها التي سترد في الأمر الثالث.
وثالثها: أن خلفاً -رحمه الله- أخذ القراءة عن شيخه سليم بن عيسى عرضا لا سماعا منه، ومعنى العرض أن يقرأ خلف ويسمع منه سليم، أو يسمع خلف من يقرأ على سليم.. ومع أن السماع من تلاوة الشيخ أصح وأبلغ فلنفترض - مراعاة للاختلاف(5) - أن العرض أبلغ من السماع، أو أنه مثله: إلا أن هذه القراءة المحالة أو المتكلفة بتصرف يغير ضبط الصاد ويزيدها زايا موجب تقديم الاحتمالات التي تنفيها؛ فيحتمل أن خلفا سمع العرض على سليم بتلاوة رجل آخر، وظن أنه تصرف هذا التصرف في الصاد مع أن سليما لم يلاحظ ذلك؛ فيكون سمع خلف هو الذي أخطأ، وليس سمع سليم مخطئا.. ويحتمل أن عرض خلف بتلاوته هو على سليم، ولم يتبين لسليم تصرف خلف؛ لخفوت صوت خلف، أو لإخطاء سمع سليم؛ فلا تكون القراءة حينئذ منسوبة إلى حمزة.. واحتمال إخطاء سمع سليم يكون على الرغم من أمر حمزة طلابه بالتحفظ والتثبت إذا أقبل سليم(6)؛ وما هذا إلا لرهافة سمعه ودقه إحساسه.. ويدلك على استحالة هذا الإشمام أن شيخ المقرئين عبدالباسط لما أراده عجز عنه؛ فجاء بالصاد المهملة ضاداً معجمة!
2- التلحين الموحش المتجاوز التغني إلى الغناء الملحن كما في تلاوته لسورة (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) (سورة الشمس-1) في بعض أشرطة قصار السور؛ فإن هذا غناء بحت متكلف يحبه من يحب الطرب، وكلام الله سبحانه مقدس عن ذلك.
3- حلاوة الصوت، وجمال الأداء في تلاوته إذا لم يلحن؛ فتستمتع بالصوت أيما استمتاع، ولكنه لا يجلب الخشية والخشوع من ذاته، وإنما يخشع ويبكي بعض المرات من كان ذا وعي بمعنى الآية الكريمة ولامست أحاسيسه، وهذا مثلا بخلاف تلاوة الشيخ عادل الكلباني؛ فإنه أحيانا يعينك على نفسك في الخشوع والبكاء وإن لم يكن من كبار القراء في صناعة التجويد.. وأما قراءة الترتيل بدون إمعان في التجويد فتقل فيه أحيانا حلاوة صوت عبدالباسط.
4- الهينمات الصوفية، والتجاوز في الدعاء فيما يختم به التلاوة بعض المرات.
5- ترديد الآية والآيات لزيادة قراءة صحيحة، أو للعبرة؛ لما فيها من معنى ظاهر يلامس الإحساس لا بأس به، وما عدا ذلك فعبث ولاسيما ما كان مشكل المعنى مثل {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ... الآي} (سورة الأعراف-172).. وأكثر إعادات عبدالباسط من أجل زيادة قراءة، أو عند انقطاع النفس على غير موقف.
6- ضجيج المستمعين للتلاوة مثل: الله يكرمك، والله ينعم عليك، يا صلاة الزين، الصلاة على النبي، والله أكبر؛ فكل هذا من البدع، والمشروع الإنصات بصمت، والإسرار: بالتأمين، والدعاء، وسؤال رحمة الله وفضله، والاستعاذة به في آيات الترغيب والترهيب، والتقديس عند ذكر أسمائه الحسنى وأفعاله سبحانه.
ولقد أفتى علي السيستاني -وهو مرجع شيعي- بتحريم تلاوة عبدالباسط، وأحمد العجمي، وتحول هذا التحريم إلى عمل؛ فقامت المليشيات الشيعية بمصادرة أشرطته، وفرضوا ذلك على محطة الشرق الفضائية، ورفض ذلك مديرها الدكتور سعد البزاز سكرتير عدي سابقا(7).
قال أبو عبدالرحمن: تلاوة عبدالباسط ثلاثة أقسام: تلاوة ليس بها محذور (وهي الترتيل)، وتجويد يوجد فيه التلحين أحيانا، وتلحين محض؛ فينبغي التفريق.. غفر الله له ورحمه.
قال أبو عبدالرحمن: أترابي الذين تناوشوا سبعين عاما أو سلخوها، ومَن قبلهم من أجيال في عصور العامية -ولو كان ذلك بعد إشراف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله- ظلموا كثيرا في التلاوة واللغة، وسأقصر حديثي على جيلي الذين عاشوا التعليم المدني أيام الدراسة المرحلية؛ فقد كان التجويد مقررا لنا في مرحلة الابتدائي فقط، وكان علما نظريا(8) بحتا ولا سيما إن كان المدرس سعوديا؛ لأنه لا يملك الأداء الصحيح تطبيقا وإن حذقه نظريا، ولم يكن في بيئتنا مقرئون يحسنون التجويد، وإنما يوجد نوادر من شيوخ العوام الأتقياء الذين يملكون حلاوة الصوت ولا يحسنون التجويد، ولكنهم يحسنون الإمعان في القرآن وتدبره مع سلامة تنشئتهم على الفطرة؛ فهذه الظاهرة تجعل المستمع يخشع ويبكي ويطرب لحلاوة الصوت على الرغم من صغر سن المستمع.. وأكثر هؤلاء الأتقياء لا يملك حلاوة الصوت ولا الإبانة، وكأنه في تلاوته يفرقع حصى صلدا من أعلى الجبل إلى أسفله.. هذه واحدة، والثانية أن التجويد من صميم لغة العرب وجمالياتها؛ لأن العرب تعطي الحرف مسافته الزمنية من مخرجه، وتنبر نبرا عروضيا -ولا أريد نبر الهمزة في اللغة-؛ فيظهر من هيئة نطقهم معنى التعجب والتوجع والاستغاثة والسؤال والإنكار والتقرير والوعد والإيعاد.. الخ، وهذا معنى الفصاحة ومعنى شطر من البلاغة؛ فكان أداؤهم جماليا مطربا، وبيئتنا محرومة من هذه النعمة؛ فأصيبت حلوقنا بتخثر البحة والخنة والحشرجة، وبليت ألسنتنا بالعنة (بالعين المهملة)؛ بالالتهام للكلام، وسبق اللسان للفكر؛ فكان طالب العلم عندنا يقول: (رسول الله صَلَّهْ عليه وسلم) يريد (صلى الله!!!)، وهذا مثل بعض الأقطار المجاورة تقول: (الله بالخير) أي (صبحك الله بالخير)؛ فأصبحت (الله بالخير) مثلا يطلق على من لا يميز بين كوعه وكرسوعه، وعُشر عالم مصري مثلا يوصل علمه بذلاقة لسانه بتأثير البيئة ذات القراء (وإن لم يكن هو فصيحا على أداء العرب بالتمام) إلى طلابه أكثر من العالم المبرز عندنا.. وكان شيخنا وشيخ الأجيال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لا يلحن نحوا في كلامه العادي، ولكنه رحمه الله كأبناء بيئته يلتهم الكلام أحيانا؛ إذن(9) عشنا في بيئة مزكومة اللغة.. وكانت بيئتنا بحمد الله نقية تقية توسعت في باب سد الذرايع؛ فلم ندرس نظرية المعرفة؛ لأن من تمنطق تزندق، ولم نتكلم بأداء عربي فصيح جميل مطرب؛ لأن من تحرى غير ما في بيئته فقد تشدق.. والتشدق مذموم!!.. ولم نلتذ بكلام الله من خلال مقرئ يتغنى بكلام الله وفق لغة العرب التي نزل بها القرآن؛ لأن من تعدى تلاوة البيئة فقد تفيهق.. والتشدق والتفيهق والتمنطق كلها في سمط المذمومات؛ فاستحوذ علينا الشيطان، وحبب إلينا أصوات الغناء لا التغني؛ فإن أخذتنا السكرة ردحنا مع أم كلثوم والسنباطي.. الخ.. الخ.. وإن أخذتنا الفكرة ردحنا مع ألحان عبدالباسط في غنائه بالقرآن الكريم في مثل (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) في شريط قصار الصور.. ومنذ خلعت خمسين عاما اشتد التجاذب والتطاحن عندي بين غرائز الإنابة، وغرائر الفكر، وغرائز الهوى؛ فلما أوشكت على خلع سبعين عاما عقب تلاوة مؤثرة خنقتني عبرة مباشرة لا أعرف سببها، ثم أحسنت الوضوء، ثم أحسنت الصلاة في جلاد مرير مع الخناس الوسواس، وفتح لي في السجود بدعاء لم يكن ببالي قط -وهي إيقاظ ملك كريم من رب رحيم- فقلت من غير تعمل، بل كأن ممليا يملي علي: (يارب إن وسيلتي إليك، وشفيعي عندك أنني منذ الصغر حتى هذه اللحظة أشهد أنه لا إله إلا أنت، وأن محمد عبدك ورسولك، وأنني مؤمن بملائكتك وكتبك ورسلك، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.. وأنني ألوذ بك، وأعتصم بك، وأسألك هداية التوفيق، وأبرأ من الحول والقوة إلا بك).. ثم غلبني البكاء فلم أحص من كلامي شيئا إلا استعاذتي مما يجلب غضب ربي ومقته ومكره، وأردد الحديث الذي فيه: (وأعوذ بك منك)، ونسيت نفسي في سجودي أدعو ربي ألا يقذف بي في النار، وألا يخترمني على كفر أو فسق، وأن يصحب بقية عمري بالعصمة والعفو عما سلف، وأن ييسر لي طاعته وعبادته والعلم النافع تعلما وتعليما عوضا عن سهر ليال في علم غير نافع -بأوراق مبعثرة تنيف على ثلاث مئة رزمة-؛ فذهبت كل تلك الليالي سبهللا.. وكنت إذا أردت أن أترك ما أراه معصية لا أعاهد ربي على ذلك خوفا من عودتي فيبطش ربي بي، ويحيقني بمكره؛ لأن الإصرار مع الاستغفار مكر، والله يمكر بمن يمكر به.. وإنما أقول في سجودي: (ها أنا يا ربي أعلن إقلاعي وندمي وعزيمتي على عدم العودة عزيمة لا عهدا، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت المستعان؛ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين).. وبعدها تدرجت في معارج من حياتي أثلجت صدري، ولا أزال أتنقل من حسن إلى أحسن، وتدربت على أن يكون لتلاوة كتاب الله (بتدبر من غير استعجال على ختم القرآن) نصيب من وقتي، وأن أقضي رياضتي على السير الكهربائي بتمهل على امتحان أصوات المقرئين من كل بلد، والانتقاء من أصواتهم، والتدبر للتلاوة.. وأحضر بجني المصحف عند تلاوتي دفترا وجزءا من تفسير القرطبي فيه السورة التي أتلوها؛ فأراجع بسرعة ما أشكل علي؛ فإن تكاسلت سجلت رقم الآية ونوع الإشكال؛ لأراجعه فيما بعد، فكنت أحقق مسائل وأسودها كلما وجدت نشاطا، وكنت سابقا أستوحش إذا طال استماعي لمن أحبهم من المطربين؛ فما كانوا اليوم عندي يقومون ولا يقعدون، ولا أجد نفسي تميل إليهم؛ فعلمت سر الصدق مع الرب في الإنابة، والاعتراف بالذنب والتقصير؛ والإلحاح في الدعاء.. ثم بعد ذلك تيقنت السر العظيم في الشد إلى الله بصوت جميل صاحبه رباني ذو علم وخشية يتغنى بكلام الله.. ولو نشأنا على هذه الأصوات الربانية لما هوّم بنا الوسواس الخناس إلى (أنت عمري) و(وسط الطريق).. الخ.. الخ.
ثم أدركت أسبابا سببت بقاءنا على الأمية العامية في التلاوة، وهي عامية لا تملك صوتا جميلا يتغنى بكلام الله على طريق الفصحى التي نزل بها القرآن، وعلق بذهني الأسباب التالية:
أ- أن كبار القراء كانوا خارج محيطنا.. ومحيطنا المنطقة الوسطى، وجنوب الجزيرة ما بين نجد واليمن والمخلاف السليماني.
ب- أننا عرفنا كبار القراء مع جهاز الراديو، ومن خلال الصحف والمجلات.
ج- رأوهم حليقي اللحى، وهي معصية تشمئز منها بيئتنا.
د- قرأوا وسمعوا من أخبار بعضهم أنه يشرب الدخان، ويشرب بعضهم ما يمزج مع الدخان أو ما هو مثله مما روجه دجالو الصوفية المدعون الجذب والكشف والوجد.. ولا ريب أن الدخان وحده يرفضه الاجتهاد بالاستنباط إلى درجة التحريم؛ لمضاره الدنيوية، ولعزله صاحبه عن الاختلاط الطويل بالصالحين.. وهذا حق في ذاته، ولكنه لا يطفئ نور الإيمان، ولا يصد عن ذكر الله، ولا يقسي القلب، ولا يمنع من الاستنصار بالله على الهوى والنفس والشيطان وضعف الإرادة؛ فتحصل العصمة على المدى، ونية المؤمن خير من عمله، والطاعات وإن صغرت تجر إلى طاعة أكبر على المدى أيضا، والإقلاع عن بعض الذنوب وإن صغرت يجر إلى التجرد من الفواحش ما ظهر منها وما بطن على المدى أيضا، وربما رفع الله درجة المؤمن العاصي إلى درجة المحسنين، وجعل خلقه القرآن، وختم له بخير؛ فمحيت ذنوبه؛ فكان كيوم ولدته أمه، ولم يجد أمامه إلا رحمة ربه وعمله القاصر أو الطيب الذي ختم له به مضاعفا أضعافا كثيرة بإحسان ربه، ونحن لا نسأل الله عدله، فذلك وعد حتمي كتبه ربنا على نفسه برحمته؛ فهو القادر المتصرف في ملكه لا غالب لأمره، ومن عامله ربه بعدله هلك، وإنما نسأله رحمة ربنا ولطفه وهدايته التوفيقية بعد هدايته الإيضاحية البيانية في الشرع والكون؛ لأن ذلك هو طلب الإذن من ربنا بالإيمان والصلاح، فالله سبحانه قال: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ} (سورة يونس-100)، وقال: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (سورة غافر-60)؛ فالدعاء من الأسباب إلى الآخرة كما نبذل الأسباب لدنيانا بطلب الحرث والنسل والصحة والغنى.
هـ- أن غالب هؤلاء القراء على هدي الصوفية في الضجيج والبدع.. وعلى هدي البدعة في التكلف والتحزين.
و- أنه لا يغلب أحدهم البكاء والخشية في تلاوته، ولا تجد ذلك في ضجيج السميعة، وإنما التلاوة عندهم حرفة للتطريب؛ فتذكر قومنا قراء يأتون آخر الزمان لا تتجاوز قراءتهم حناجرهم.
قال أبو عبدالرحمن: كل هذا حق، ولكنه لا يمنع من تخليص الحق من الأوشاب، ولا يمنع من اعترافنا بأننا على نقص وأخطاء جسيمة في ترك بذل الأسباب لإيجاد كوكبة تحسن التغني بالقرآن بالأصوات الجميلة الخشوعة المتدربة بعد الله بالعلم على ما يؤدي به خيار الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم (وهم سادة الفصحى) كلام ربهم بما يرضي ربهم؛ فيحسن الناس الانتفاع بكلام الله، فبئس التاريخ في بيئتنا عصور تلك العامية التي يعشعش عليها الإلف والعادة، وخمود الفكر عن النظر بحرية ثم الالتزام لما دلت عليه عزائم الفكر من يقين ورجحان؛ فإن ربنا سبحانه في نزول القرآن بمكة المكرمة خاطب العقل والفؤاد (الذي هو مستقر المعقول إذا تحول إلى إيمان) والسمع والبصر، قبل المخاطبة بتكليف الشرع بالمدينة المنورة؛ لأنه إذا حصل الإيمان اليقيني بما يوجب السمع والبصر والفؤاد الإيمان به، وإذا حصل الإيمان الرجحاني فيما جعله الله للاجتهاد المؤهل: سهل الانقياد للشرع بتلذذ وشوق.. ومعذرة من هذا التدافع المنثال من الكث والبث؛ فلولا يقيني بانتفاع القارئ بتجربتي ما بثثت من سري شيئا.. ثم اعلموا أن كل بكاء أو قشعريرة أو عبرة في عبادة أي عبادة كالانكسار أمام الله بالدعاء في صلاة، أو خلوة، أو تلاوة، ولم يكن عن اعتبار بآية فهمت معناها المتوثب بالأرواح، ولم تعرف لتلك الخشية سببا: فسببها حفيف ملائكة الرحمن بك؛ فإن الله بث ملائكته عليهم السلام منهم كتبة الأعمال، ومنهم من يحفظك بأمر الله حتى يأتي أجلك أو قدرك الدنيوي الحتمي؛ وذلك نعمة للمؤمنين الشاكرين، وحجة على الكافرين الجاحدين ونقمة عليهم، ومنهم من يعينك على وساوس الشيطان بطمأنينة من الله، ومنهم من يغشى خلوتك في التلاوة والعبادة والانكسار فيدعو لك، ويستغفر الله لك بأن يقيك السيئات؛ فخذها مني حقيقة مطلقة قاطعة عن تجربة معاناة أن كل ما ذكرته هو من حفيف الملائكة، وهو بشرى للمؤمن، والله المستعان.
وكتبه لكم:
أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري
- عفا الله عنه -
(1) ينظر عنه تتمة الأعلام للشيخ محمد خير رمضان ص265-266، وكذلك موقع عبدالباسط في الإنترنت، وقد نقلوا عن مذكراته.
(2) قرأ خلف بإشمام الصاد زاياً، والإشمام هو: (ضم الشفتين للتلفظ بالضم من غير صوت يُسمع؛ تنبيهاً على ضم ما قبلها أو ضمة الحرف الموقوف عليه ولا يشعر به الأعمى).. زاد المسير 4-186.. وقال أبو عبدالرحمن: هذا إشمام حركة، ولا علاقة له بموضوع الآية الذي هو إشمام الحرف.. قال الإمام نصر بن علي ابن أبي مريم (-ت بعد 565هـ) رحمه الله تعالى في الموضح في وجوه القراءات وعللها 1-169 (بتحقيق الدكتور عمر حمدان الكبيسي - نشر الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة- الطبعة الأولى عام 1414هـ): (الصاد التي هي كالزاي، وهي تسمى المضارعة بين الزاي والصاد نحو (الزراط) إذا لم تجعلها زاياً خالصة ولا صاداً خالصة، وذكر 1-230 أنها قراءة ابن كثير برواية قنبل، ويعقوب برواية رويس، وأنها قراءة حمزة وحده برواية خلف في سورة الغاشية كما في 3- 1364، وذكر كراهية بعضهم لهذه القراءة لما فيها من تكلُّف.
(3) الجعد قصير الشعر، والقطط بلوغ الغاية في الجعودة، والسبط المسترسل، وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطاً لا سبطاً ولا جعداً، فالجعودة ليست وسطية، فلم يصادف المعنى الذي يريده حمزة رحمه الله لفظاً دالاً عليه، ولو قال: (وليس ما دون السبط إلا الاعتدال، أو الجعد القطط): لكان أوفق.
(4) انظر غاية النهاية في طبقات القراءة لابن الجزري رحمه الله تعالى 1-263- دار الكتب العلمية ببيروت.
(5) انظر في علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى ص137-138- دار الفكر المعاصر ببيروت مع دار الفكر بدمشق.
(6) غاية النهاية 1-319.
(7) عن الإنترنت عن دنيا الوطن ببغداد عن الدكتور أحمد الديلمي.
(8) مادام بعد الياء ألفُ تقتضي علامة تنوين فالأولى جعل الشدة والسكون على الياء الأولى، والتنوين هو للياء الثانية.
(9) كان المبرد رحمه الله يتمنى أن يكوي يد من كتبها (إذاً) لأن النون أصلية في الحرف مثل عن وعند.
كتبه أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري
مقال منشور في جريدة الجزيرة يوم الخميس 23/4/1428 وفيه بعض الفوائد واللطائف. على أني لا أتفق مع الكاتب الكريم في بعض الأمور التي ذكرها.
الشيخ عبدالباسط بن محمد بن عبدالصمد -رحمه الله- من أحلى المقرئين صوتاً بإطلاق وأطولهم نفساً.. إلا أن لي بعض الملاحظات على تلاوته بعد قليل إن شاء الله، ولهذا نُسي، واستبدل به ذوو التلاوة المجودة منذ الشيخ الحذيفي إلى شبابنا حفظهم الله.. ولد رحمه الله سنة 1346هـ- 1927م، وتوفي سنة 1409هـ- 1988م، وهو شيخ المقرئين المصريين، ورئيس نقابة قراء ومحققي القرآن الكريم في مصر، وعضو المجلس الأعلى الإسلامي، وكان والده من أكراد العراق.. حفظ القرآن ولم يتجاوز العاشرة من عمره - فليعتبر شباب العصر-، وأتقن القراءات السبع ولم يتجاوز أربعة عشر عاماً(1).
قال أبو عبدالرحمن: ولا تزال ترتبط ذكرى تلاوة عبدالباسط بذهني ووجداني في صغري أيام الراديو الفيلبس الكبير الذي نشغله على البطارية، ويستفتح بصوته الإذاعات؛ فكنا نصغي إليه عند وجبة الفطور قبل الذهاب إلى المدرسة، وهكذا تستقبلنا نوافذ المربع بالرياض إذا زرناه في العطلة، حيث يسكن بعض أصدقاء الوالد -رحمه الله- في غرف بالمربع؛ فلا تسمع إلا صوت عبدالباسط بأعلى ارتفاع من صوت الراديو؛ وكان أخي عبدالله -رحمه الله- مشهوراً في شقراء بالإجادة المطابقة لصوت عبدالباسط عبدالصمد مع انقطاع قليل في النفس، كما كان يقلد المنشاوي، ومحمد رفعت، ومحمود خليل الحصري، وأبوالعينين شعيشع.. وكان الوالد -رحمه الله- يذهب به إلى مرقده في الموعد المحدد على الرغم منه؛ لأنه يقضي الليل في تحريك مفتاح الراديو يميناً وشمالاً يتحرى كل إذاعة تستفتح بتلاوة أحد هؤلاء.. وأمثل القراء المصريين المشهورين تجويداً المنشاوي، ومحمد محمود الطبلاوي، ومحمود خليل الحصري، ومحمد رفعت، وأبوالعينين شعيشع.. ذكرتهم على الترتيب في الإجادة، والطبلاوي طويل النفس، متقن للتجويد بلا تكلف، موفق في نطق الحروف من مخارجها.. إلا أنه مثل أكثر المقرئين -إذا لم تكن أشرطته مدبلجة.. أي محذوفة السكتات- لا يقف للدعاء والاستعاذة والتسبيح عند آيات الترغيب والترهيب والتقديس؛ فيفوته أجر ذلك، ولكن المستمع لن يغفل عن ذلك؛ لأن تلاوته تقتضي الخشية، وهذه خصيصة له وحده بينهم، والحصري دونه في التجويد ولم يرزق حلاوة صوت، وأبوالعينين أحلاهم صوتاً، ويضارع الطبلاوي في طول النفس؛ إلا أنه يقف كثيراً عند كل آية أو جزء من آية وإن لم يكن فيها ما يقتضي التسبيح أو الدعاء أو الاستعاذة؛ بسبب تكلفه في رفع الصوت؛ فيأخذ نفساً طويلاً، وقد يخفض الصوت؛ فلا تكون تلاوته على وتيرة واحدة.. ويشترك مع محمد رفعت في أنهما يميلان إلى التحزين ولا تتبين تلاوتهما أحياناً؛ فهما أكثر تكلفاً في التجويد والتحزين.. إلا أن محمد رفعت أحلى صوتاً، وأقرب إلى التحزين شبه الطبيعي إلا في تلاوة له لسورة (اقتربت الساعة)؛ فقد تكلف التحزين.. والطبلاوي يراعي النبر العروضي أحياناً وهو إظهار التعجب والإنكار والتساؤل.. الخ.. والملاحظ على عبدالباسط رحمه الله ما يلي:
1- أنه ينبغي التثبت من القراءات التي يقرأ بها؛ فإنه قرأ في سورة الغاشية (بمضيطر) بضاد معجمة بعد الميم، ولا تعرف هذه القراءة عن أحد، وإنما ورد في قراءة لا يعتد بها نقلا إشمام الصاد زاياً، وهذا الإشمام(2) (مع عدم إمكانه) لا يقتضي النطق بالضاد.
قال أبو عبدالرحمن: والعجب تصحيحها عند بعض النحاة وفي كتب بعض القراءات، وأرى أن إشمام الصاد زاياً ليس من الحروف الفرعية؛ لأنه محال النطق به، وما كان محالاً فليس حرفاً.. وهذه الإحالة بالنسبة للآية من سورة الغاشية (بِمُصَيْطِرٍ)؛ قراءة تفرد بها خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي: عن سليم بن عيسى: عن حمزة رحمهم الله تعالى، والظاهر أنه سمعها بتصرف في الصاد بأن جعلها ساكنة وأتمها بزيادة زاي مكسورة.. ولا يمكن أن يتصور إشمام الصاد زايا بغير هذه الصورة؛ لأن طبيعة الصوت البشري بمخارجه لا يوجد حرف فرعي بين الصاد والزاي مثل الكاف في (كيف حالك؟) في عامية نجد، فلها في الصوت البشري مخرج بين الجيم والكاف، وهكذا (الصِّرَاطَ).. يستحيل أن تجد له مخرجاً بين الصاد والزاي، ومحال أن تجد له شمامة بين الصاد والزاي بخلاف الصاد والسين فإنك تخفف نطق الصاد فلا تلفظ بها من مخرجها خالصة، بل تميل إلى السين أيضاً من دون أن تلفظ بها خالصة من مخرجها، وهذا تكلف متعب، وأما ما بين الصاد والزاي فهو محال.. والتقارب اللغوي بين معاني صراط وسرط وزرط لا يسوغ نطقاً متكلفاً أو دعوى نطق محال، وإنما يتصور نطق الصاد ساكنة بعدها زاي مكسورة، وهذا تصرف في حرف الصاد، وزيادة حرف زاي، ولا يقبل في كلام الله إلا ببرهان قوي.. وحمزة هو الإمام حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي -رحمه الله تعالى- من أئمة القراءات السبع، ولكن هذه القراءة عنه ليست سبعية؛ لأن راويها عن تلميذه سليم هو خلف بن هشام -رحمه الله- إمام من القراء العشرة؛ فعلى فرض صحة الممكن (الذي أسلفته من إشمام الصاد زاياً) عن سليم؛ فيكون سليم -وإن كان أقوم تلاميذ حمزة بحرفه- منفرداً عن بقية تلاميذ حمزة، ولكن الأظهر -لإحالة الإشمام، والاحتياج إلى إسكان الصاد وإتمامها بزاي مكسورة- أنها لا تثبت عن سليم وإن كان راويها خلف إماماً لأمور:
أولها: أن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- كره قراءة حمزة؛ فلما بحث عن السبب وجد أنه انفراد بعض القراء بالرواية عنه؛ فأحد الرواة عن سليم عن حمزة سمع مقرئاً يروي قراءته عن حمزة وفيها إفراط في المد؛ فكره ابن إدريس ذلك.. ومعنى هذا أنها لم تثبت عن حمزة؛ لأن أبا عمارة حمزة -رحمه الله- كان يقول ناهيا لرجل: (أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق الجعودة فهو قطط(3)، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة)(4).
وثانيها: أن هذا الانفراد عن أصحاب سليم بن عيسى تلميذ حمزة، وهذا الانفراد عن بقية تلاميذ حمزة في أمر محال أو تصرف متكلف: قاض بترجيح الاحتمالات القاضية بردها التي سترد في الأمر الثالث.
وثالثها: أن خلفاً -رحمه الله- أخذ القراءة عن شيخه سليم بن عيسى عرضا لا سماعا منه، ومعنى العرض أن يقرأ خلف ويسمع منه سليم، أو يسمع خلف من يقرأ على سليم.. ومع أن السماع من تلاوة الشيخ أصح وأبلغ فلنفترض - مراعاة للاختلاف(5) - أن العرض أبلغ من السماع، أو أنه مثله: إلا أن هذه القراءة المحالة أو المتكلفة بتصرف يغير ضبط الصاد ويزيدها زايا موجب تقديم الاحتمالات التي تنفيها؛ فيحتمل أن خلفا سمع العرض على سليم بتلاوة رجل آخر، وظن أنه تصرف هذا التصرف في الصاد مع أن سليما لم يلاحظ ذلك؛ فيكون سمع خلف هو الذي أخطأ، وليس سمع سليم مخطئا.. ويحتمل أن عرض خلف بتلاوته هو على سليم، ولم يتبين لسليم تصرف خلف؛ لخفوت صوت خلف، أو لإخطاء سمع سليم؛ فلا تكون القراءة حينئذ منسوبة إلى حمزة.. واحتمال إخطاء سمع سليم يكون على الرغم من أمر حمزة طلابه بالتحفظ والتثبت إذا أقبل سليم(6)؛ وما هذا إلا لرهافة سمعه ودقه إحساسه.. ويدلك على استحالة هذا الإشمام أن شيخ المقرئين عبدالباسط لما أراده عجز عنه؛ فجاء بالصاد المهملة ضاداً معجمة!
2- التلحين الموحش المتجاوز التغني إلى الغناء الملحن كما في تلاوته لسورة (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) (سورة الشمس-1) في بعض أشرطة قصار السور؛ فإن هذا غناء بحت متكلف يحبه من يحب الطرب، وكلام الله سبحانه مقدس عن ذلك.
3- حلاوة الصوت، وجمال الأداء في تلاوته إذا لم يلحن؛ فتستمتع بالصوت أيما استمتاع، ولكنه لا يجلب الخشية والخشوع من ذاته، وإنما يخشع ويبكي بعض المرات من كان ذا وعي بمعنى الآية الكريمة ولامست أحاسيسه، وهذا مثلا بخلاف تلاوة الشيخ عادل الكلباني؛ فإنه أحيانا يعينك على نفسك في الخشوع والبكاء وإن لم يكن من كبار القراء في صناعة التجويد.. وأما قراءة الترتيل بدون إمعان في التجويد فتقل فيه أحيانا حلاوة صوت عبدالباسط.
4- الهينمات الصوفية، والتجاوز في الدعاء فيما يختم به التلاوة بعض المرات.
5- ترديد الآية والآيات لزيادة قراءة صحيحة، أو للعبرة؛ لما فيها من معنى ظاهر يلامس الإحساس لا بأس به، وما عدا ذلك فعبث ولاسيما ما كان مشكل المعنى مثل {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ... الآي} (سورة الأعراف-172).. وأكثر إعادات عبدالباسط من أجل زيادة قراءة، أو عند انقطاع النفس على غير موقف.
6- ضجيج المستمعين للتلاوة مثل: الله يكرمك، والله ينعم عليك، يا صلاة الزين، الصلاة على النبي، والله أكبر؛ فكل هذا من البدع، والمشروع الإنصات بصمت، والإسرار: بالتأمين، والدعاء، وسؤال رحمة الله وفضله، والاستعاذة به في آيات الترغيب والترهيب، والتقديس عند ذكر أسمائه الحسنى وأفعاله سبحانه.
ولقد أفتى علي السيستاني -وهو مرجع شيعي- بتحريم تلاوة عبدالباسط، وأحمد العجمي، وتحول هذا التحريم إلى عمل؛ فقامت المليشيات الشيعية بمصادرة أشرطته، وفرضوا ذلك على محطة الشرق الفضائية، ورفض ذلك مديرها الدكتور سعد البزاز سكرتير عدي سابقا(7).
قال أبو عبدالرحمن: تلاوة عبدالباسط ثلاثة أقسام: تلاوة ليس بها محذور (وهي الترتيل)، وتجويد يوجد فيه التلحين أحيانا، وتلحين محض؛ فينبغي التفريق.. غفر الله له ورحمه.
قال أبو عبدالرحمن: أترابي الذين تناوشوا سبعين عاما أو سلخوها، ومَن قبلهم من أجيال في عصور العامية -ولو كان ذلك بعد إشراف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله- ظلموا كثيرا في التلاوة واللغة، وسأقصر حديثي على جيلي الذين عاشوا التعليم المدني أيام الدراسة المرحلية؛ فقد كان التجويد مقررا لنا في مرحلة الابتدائي فقط، وكان علما نظريا(8) بحتا ولا سيما إن كان المدرس سعوديا؛ لأنه لا يملك الأداء الصحيح تطبيقا وإن حذقه نظريا، ولم يكن في بيئتنا مقرئون يحسنون التجويد، وإنما يوجد نوادر من شيوخ العوام الأتقياء الذين يملكون حلاوة الصوت ولا يحسنون التجويد، ولكنهم يحسنون الإمعان في القرآن وتدبره مع سلامة تنشئتهم على الفطرة؛ فهذه الظاهرة تجعل المستمع يخشع ويبكي ويطرب لحلاوة الصوت على الرغم من صغر سن المستمع.. وأكثر هؤلاء الأتقياء لا يملك حلاوة الصوت ولا الإبانة، وكأنه في تلاوته يفرقع حصى صلدا من أعلى الجبل إلى أسفله.. هذه واحدة، والثانية أن التجويد من صميم لغة العرب وجمالياتها؛ لأن العرب تعطي الحرف مسافته الزمنية من مخرجه، وتنبر نبرا عروضيا -ولا أريد نبر الهمزة في اللغة-؛ فيظهر من هيئة نطقهم معنى التعجب والتوجع والاستغاثة والسؤال والإنكار والتقرير والوعد والإيعاد.. الخ، وهذا معنى الفصاحة ومعنى شطر من البلاغة؛ فكان أداؤهم جماليا مطربا، وبيئتنا محرومة من هذه النعمة؛ فأصيبت حلوقنا بتخثر البحة والخنة والحشرجة، وبليت ألسنتنا بالعنة (بالعين المهملة)؛ بالالتهام للكلام، وسبق اللسان للفكر؛ فكان طالب العلم عندنا يقول: (رسول الله صَلَّهْ عليه وسلم) يريد (صلى الله!!!)، وهذا مثل بعض الأقطار المجاورة تقول: (الله بالخير) أي (صبحك الله بالخير)؛ فأصبحت (الله بالخير) مثلا يطلق على من لا يميز بين كوعه وكرسوعه، وعُشر عالم مصري مثلا يوصل علمه بذلاقة لسانه بتأثير البيئة ذات القراء (وإن لم يكن هو فصيحا على أداء العرب بالتمام) إلى طلابه أكثر من العالم المبرز عندنا.. وكان شيخنا وشيخ الأجيال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لا يلحن نحوا في كلامه العادي، ولكنه رحمه الله كأبناء بيئته يلتهم الكلام أحيانا؛ إذن(9) عشنا في بيئة مزكومة اللغة.. وكانت بيئتنا بحمد الله نقية تقية توسعت في باب سد الذرايع؛ فلم ندرس نظرية المعرفة؛ لأن من تمنطق تزندق، ولم نتكلم بأداء عربي فصيح جميل مطرب؛ لأن من تحرى غير ما في بيئته فقد تشدق.. والتشدق مذموم!!.. ولم نلتذ بكلام الله من خلال مقرئ يتغنى بكلام الله وفق لغة العرب التي نزل بها القرآن؛ لأن من تعدى تلاوة البيئة فقد تفيهق.. والتشدق والتفيهق والتمنطق كلها في سمط المذمومات؛ فاستحوذ علينا الشيطان، وحبب إلينا أصوات الغناء لا التغني؛ فإن أخذتنا السكرة ردحنا مع أم كلثوم والسنباطي.. الخ.. الخ.. وإن أخذتنا الفكرة ردحنا مع ألحان عبدالباسط في غنائه بالقرآن الكريم في مثل (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) في شريط قصار الصور.. ومنذ خلعت خمسين عاما اشتد التجاذب والتطاحن عندي بين غرائز الإنابة، وغرائر الفكر، وغرائز الهوى؛ فلما أوشكت على خلع سبعين عاما عقب تلاوة مؤثرة خنقتني عبرة مباشرة لا أعرف سببها، ثم أحسنت الوضوء، ثم أحسنت الصلاة في جلاد مرير مع الخناس الوسواس، وفتح لي في السجود بدعاء لم يكن ببالي قط -وهي إيقاظ ملك كريم من رب رحيم- فقلت من غير تعمل، بل كأن ممليا يملي علي: (يارب إن وسيلتي إليك، وشفيعي عندك أنني منذ الصغر حتى هذه اللحظة أشهد أنه لا إله إلا أنت، وأن محمد عبدك ورسولك، وأنني مؤمن بملائكتك وكتبك ورسلك، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.. وأنني ألوذ بك، وأعتصم بك، وأسألك هداية التوفيق، وأبرأ من الحول والقوة إلا بك).. ثم غلبني البكاء فلم أحص من كلامي شيئا إلا استعاذتي مما يجلب غضب ربي ومقته ومكره، وأردد الحديث الذي فيه: (وأعوذ بك منك)، ونسيت نفسي في سجودي أدعو ربي ألا يقذف بي في النار، وألا يخترمني على كفر أو فسق، وأن يصحب بقية عمري بالعصمة والعفو عما سلف، وأن ييسر لي طاعته وعبادته والعلم النافع تعلما وتعليما عوضا عن سهر ليال في علم غير نافع -بأوراق مبعثرة تنيف على ثلاث مئة رزمة-؛ فذهبت كل تلك الليالي سبهللا.. وكنت إذا أردت أن أترك ما أراه معصية لا أعاهد ربي على ذلك خوفا من عودتي فيبطش ربي بي، ويحيقني بمكره؛ لأن الإصرار مع الاستغفار مكر، والله يمكر بمن يمكر به.. وإنما أقول في سجودي: (ها أنا يا ربي أعلن إقلاعي وندمي وعزيمتي على عدم العودة عزيمة لا عهدا، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت المستعان؛ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين).. وبعدها تدرجت في معارج من حياتي أثلجت صدري، ولا أزال أتنقل من حسن إلى أحسن، وتدربت على أن يكون لتلاوة كتاب الله (بتدبر من غير استعجال على ختم القرآن) نصيب من وقتي، وأن أقضي رياضتي على السير الكهربائي بتمهل على امتحان أصوات المقرئين من كل بلد، والانتقاء من أصواتهم، والتدبر للتلاوة.. وأحضر بجني المصحف عند تلاوتي دفترا وجزءا من تفسير القرطبي فيه السورة التي أتلوها؛ فأراجع بسرعة ما أشكل علي؛ فإن تكاسلت سجلت رقم الآية ونوع الإشكال؛ لأراجعه فيما بعد، فكنت أحقق مسائل وأسودها كلما وجدت نشاطا، وكنت سابقا أستوحش إذا طال استماعي لمن أحبهم من المطربين؛ فما كانوا اليوم عندي يقومون ولا يقعدون، ولا أجد نفسي تميل إليهم؛ فعلمت سر الصدق مع الرب في الإنابة، والاعتراف بالذنب والتقصير؛ والإلحاح في الدعاء.. ثم بعد ذلك تيقنت السر العظيم في الشد إلى الله بصوت جميل صاحبه رباني ذو علم وخشية يتغنى بكلام الله.. ولو نشأنا على هذه الأصوات الربانية لما هوّم بنا الوسواس الخناس إلى (أنت عمري) و(وسط الطريق).. الخ.. الخ.
ثم أدركت أسبابا سببت بقاءنا على الأمية العامية في التلاوة، وهي عامية لا تملك صوتا جميلا يتغنى بكلام الله على طريق الفصحى التي نزل بها القرآن، وعلق بذهني الأسباب التالية:
أ- أن كبار القراء كانوا خارج محيطنا.. ومحيطنا المنطقة الوسطى، وجنوب الجزيرة ما بين نجد واليمن والمخلاف السليماني.
ب- أننا عرفنا كبار القراء مع جهاز الراديو، ومن خلال الصحف والمجلات.
ج- رأوهم حليقي اللحى، وهي معصية تشمئز منها بيئتنا.
د- قرأوا وسمعوا من أخبار بعضهم أنه يشرب الدخان، ويشرب بعضهم ما يمزج مع الدخان أو ما هو مثله مما روجه دجالو الصوفية المدعون الجذب والكشف والوجد.. ولا ريب أن الدخان وحده يرفضه الاجتهاد بالاستنباط إلى درجة التحريم؛ لمضاره الدنيوية، ولعزله صاحبه عن الاختلاط الطويل بالصالحين.. وهذا حق في ذاته، ولكنه لا يطفئ نور الإيمان، ولا يصد عن ذكر الله، ولا يقسي القلب، ولا يمنع من الاستنصار بالله على الهوى والنفس والشيطان وضعف الإرادة؛ فتحصل العصمة على المدى، ونية المؤمن خير من عمله، والطاعات وإن صغرت تجر إلى طاعة أكبر على المدى أيضا، والإقلاع عن بعض الذنوب وإن صغرت يجر إلى التجرد من الفواحش ما ظهر منها وما بطن على المدى أيضا، وربما رفع الله درجة المؤمن العاصي إلى درجة المحسنين، وجعل خلقه القرآن، وختم له بخير؛ فمحيت ذنوبه؛ فكان كيوم ولدته أمه، ولم يجد أمامه إلا رحمة ربه وعمله القاصر أو الطيب الذي ختم له به مضاعفا أضعافا كثيرة بإحسان ربه، ونحن لا نسأل الله عدله، فذلك وعد حتمي كتبه ربنا على نفسه برحمته؛ فهو القادر المتصرف في ملكه لا غالب لأمره، ومن عامله ربه بعدله هلك، وإنما نسأله رحمة ربنا ولطفه وهدايته التوفيقية بعد هدايته الإيضاحية البيانية في الشرع والكون؛ لأن ذلك هو طلب الإذن من ربنا بالإيمان والصلاح، فالله سبحانه قال: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ} (سورة يونس-100)، وقال: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (سورة غافر-60)؛ فالدعاء من الأسباب إلى الآخرة كما نبذل الأسباب لدنيانا بطلب الحرث والنسل والصحة والغنى.
هـ- أن غالب هؤلاء القراء على هدي الصوفية في الضجيج والبدع.. وعلى هدي البدعة في التكلف والتحزين.
و- أنه لا يغلب أحدهم البكاء والخشية في تلاوته، ولا تجد ذلك في ضجيج السميعة، وإنما التلاوة عندهم حرفة للتطريب؛ فتذكر قومنا قراء يأتون آخر الزمان لا تتجاوز قراءتهم حناجرهم.
قال أبو عبدالرحمن: كل هذا حق، ولكنه لا يمنع من تخليص الحق من الأوشاب، ولا يمنع من اعترافنا بأننا على نقص وأخطاء جسيمة في ترك بذل الأسباب لإيجاد كوكبة تحسن التغني بالقرآن بالأصوات الجميلة الخشوعة المتدربة بعد الله بالعلم على ما يؤدي به خيار الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم (وهم سادة الفصحى) كلام ربهم بما يرضي ربهم؛ فيحسن الناس الانتفاع بكلام الله، فبئس التاريخ في بيئتنا عصور تلك العامية التي يعشعش عليها الإلف والعادة، وخمود الفكر عن النظر بحرية ثم الالتزام لما دلت عليه عزائم الفكر من يقين ورجحان؛ فإن ربنا سبحانه في نزول القرآن بمكة المكرمة خاطب العقل والفؤاد (الذي هو مستقر المعقول إذا تحول إلى إيمان) والسمع والبصر، قبل المخاطبة بتكليف الشرع بالمدينة المنورة؛ لأنه إذا حصل الإيمان اليقيني بما يوجب السمع والبصر والفؤاد الإيمان به، وإذا حصل الإيمان الرجحاني فيما جعله الله للاجتهاد المؤهل: سهل الانقياد للشرع بتلذذ وشوق.. ومعذرة من هذا التدافع المنثال من الكث والبث؛ فلولا يقيني بانتفاع القارئ بتجربتي ما بثثت من سري شيئا.. ثم اعلموا أن كل بكاء أو قشعريرة أو عبرة في عبادة أي عبادة كالانكسار أمام الله بالدعاء في صلاة، أو خلوة، أو تلاوة، ولم يكن عن اعتبار بآية فهمت معناها المتوثب بالأرواح، ولم تعرف لتلك الخشية سببا: فسببها حفيف ملائكة الرحمن بك؛ فإن الله بث ملائكته عليهم السلام منهم كتبة الأعمال، ومنهم من يحفظك بأمر الله حتى يأتي أجلك أو قدرك الدنيوي الحتمي؛ وذلك نعمة للمؤمنين الشاكرين، وحجة على الكافرين الجاحدين ونقمة عليهم، ومنهم من يعينك على وساوس الشيطان بطمأنينة من الله، ومنهم من يغشى خلوتك في التلاوة والعبادة والانكسار فيدعو لك، ويستغفر الله لك بأن يقيك السيئات؛ فخذها مني حقيقة مطلقة قاطعة عن تجربة معاناة أن كل ما ذكرته هو من حفيف الملائكة، وهو بشرى للمؤمن، والله المستعان.
وكتبه لكم:
أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري
- عفا الله عنه -
(1) ينظر عنه تتمة الأعلام للشيخ محمد خير رمضان ص265-266، وكذلك موقع عبدالباسط في الإنترنت، وقد نقلوا عن مذكراته.
(2) قرأ خلف بإشمام الصاد زاياً، والإشمام هو: (ضم الشفتين للتلفظ بالضم من غير صوت يُسمع؛ تنبيهاً على ضم ما قبلها أو ضمة الحرف الموقوف عليه ولا يشعر به الأعمى).. زاد المسير 4-186.. وقال أبو عبدالرحمن: هذا إشمام حركة، ولا علاقة له بموضوع الآية الذي هو إشمام الحرف.. قال الإمام نصر بن علي ابن أبي مريم (-ت بعد 565هـ) رحمه الله تعالى في الموضح في وجوه القراءات وعللها 1-169 (بتحقيق الدكتور عمر حمدان الكبيسي - نشر الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة- الطبعة الأولى عام 1414هـ): (الصاد التي هي كالزاي، وهي تسمى المضارعة بين الزاي والصاد نحو (الزراط) إذا لم تجعلها زاياً خالصة ولا صاداً خالصة، وذكر 1-230 أنها قراءة ابن كثير برواية قنبل، ويعقوب برواية رويس، وأنها قراءة حمزة وحده برواية خلف في سورة الغاشية كما في 3- 1364، وذكر كراهية بعضهم لهذه القراءة لما فيها من تكلُّف.
(3) الجعد قصير الشعر، والقطط بلوغ الغاية في الجعودة، والسبط المسترسل، وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطاً لا سبطاً ولا جعداً، فالجعودة ليست وسطية، فلم يصادف المعنى الذي يريده حمزة رحمه الله لفظاً دالاً عليه، ولو قال: (وليس ما دون السبط إلا الاعتدال، أو الجعد القطط): لكان أوفق.
(4) انظر غاية النهاية في طبقات القراءة لابن الجزري رحمه الله تعالى 1-263- دار الكتب العلمية ببيروت.
(5) انظر في علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى ص137-138- دار الفكر المعاصر ببيروت مع دار الفكر بدمشق.
(6) غاية النهاية 1-319.
(7) عن الإنترنت عن دنيا الوطن ببغداد عن الدكتور أحمد الديلمي.
(8) مادام بعد الياء ألفُ تقتضي علامة تنوين فالأولى جعل الشدة والسكون على الياء الأولى، والتنوين هو للياء الثانية.
(9) كان المبرد رحمه الله يتمنى أن يكوي يد من كتبها (إذاً) لأن النون أصلية في الحرف مثل عن وعند.